| | ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩ |  |
|
|
| كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
الشهبندر
عضو نشيط 
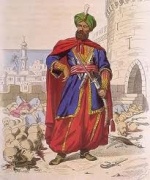
الجنس : 
العمر : 40
 المدينة المنورة المدينة المنورة
التسجيل : 30/09/2011
عدد المساهمات : 141
 |  موضوع: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩ موضوع: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩  الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:49 pm الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:49 pm | |
|
۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩
مـقـدمــة
مما لا شك فيه أن دارس المتنبي في اللحظة الراهنة ستنتابه حيرة وتردد، وهو يعقد العزم على إنجاز بحث أكاديمي حول شعره وسبب ذلك هو الكم الهائل من الدراسات التي أنجزت حوله في القديم والحديث، إذ سينتصب أمامه تحد كبير، وهو ، هل بالإمكان تقديم الجديد أمام هذا المنجز القرائي السابق، إن هذه الوضعية إيجابية وسلبية في الآن نفسه، سلبية لأنها توهمك بأن المتنبي قد قتل درسا. ولم يعد للاحق مجال للإضافة والإتيان بجديد، وإيجابية لأنها توفر للباحث مجالا خصبا لتأمل التمثلات الذهنية، والسيرورات القرائية، وتعدد التأويلات، والصور المتخلية حول المتنبي، لدى هؤلاء القراء المتتابعين عبر الزمن، من ثم فقد قر قرارنا على أن نخص دراسة للمتنبي تهتم بالأساس بفحص الطرق التي تمثلته بها المناهج النقدية الحديثة عند العرب. إن دواعي اختيار هذا المبحث، يمتزج فيها ما هو ذاتي بما هو موضوعي؛ فيما يخص الجانب الذاتي في هذا الموضوع ، فهو شغفي بشعر المتنبي منذ زمن بعيد، خصوصا وأن الصورة التي كونتها عنه في مخيلتي من خلال مباشرتي لشعره تختلف كثيرا عن الصورة المرسومة له في كتب الأخبار، أو حتى في الدراسات الحديثة التي كانت في متناولي. ومن خلال هذه التجربة مع الشاعر المنفلت، طرحت على نفسي سؤالا، قد يبدو بديهيا، ولكنه في اعتقادي، جوهري، لأنه يصب في عمق الإشكالية المنهجية، إنه سؤال يتعلق بطبيعة الصورة التي نكونها حول موضوع المدروس، أو بعبارة أخرى، هل هناك المتنبي بصيغة المفرد أم بصيغة الجمع؟ هل من الممكن أن نعيد تشكيل صورة المتنبي كما كانت في الحقيقة أم أن هذه الصورة هي من صنع القارئ وحده؟
أما الجانب الموضوعي، الذي حدا بي إلى اختيار هذا الموضوع، فيرتبط أساسا بالمسألة المنهجية، في ثقافتنا الحديثة، هذه المسألة تعتبر من القضايا الشائكة التي ما فتئت تحظى باهتمام الباحثين ، في مختلف مجالات المعرفة .
وتكتسب أهميتها ، من كون المنهج هو المفتاح الرئيس للتحكم في البحث ، والطريق اللاحب لتوليد الدلالات والأفكار الجديدة ، وإضاءة الجوانب المتعددة في النصوص . ناهيك على أن المنهج ليس أداة فحسب ، بل هو رؤية لوجود ، تسندها خلفية معرفية وفكرية تؤطره وتحدد أهدافه ومراميه .
إن إشكالية المنهج تكتسي أهميتها وخطورتها من حيث كون المنهج هو إيمان بموقف ودفاع عنه ، ومن ثم فإن علاقتنا بالمنهج في العالم العربي قد اتخذت منحيين أساسيين : فطائفة استمسكت بمناهج عربية أصلية تجد مرجعياتها في المنجز النقدي كما تمثله أسلافنا الأوائل ، وطائفة اعتمدت المناهج الغربية الحديثة ، ناقلة بذلك ما تحمله هذه المناهج من أفكار وأيديولوجيات ، وإن دل هذا التشاطر فإنما يدل على التصعد والحيرة التي تطبع توجهات المثقف العربي حيال الاصطدام بالآخر / الغرب الاستعمار-(الإمبريالي-العولمي).
وينضاف إلى هذا الدافع الموضوعي ، دافع لا يقل أهمية ، وهو تلمس أجوبة حول مسألة أضحت لصيقة بالمتنبي وتكاد تميزه عن باقي الشعراء العرب قديمهم وحديثهم ، وهي مسألة سر الاهتمام بهذا الشاعر وعوامل استمرار يته ، ويكاد هذا الجانب يستأثر بجل الدراسات التي تناولت المتنبي في العصر الحاضر ، وإن كان قد أثير لدى القدماء ، حيث ذهبوا إلى أن المتنبي مجدود في شعره ، وذهب بعض المحدثين إلى أن المتنبي شبيه بالقدر الذي لا يغالب ، وقد أوردت كتب الأخبار مجموعة من الحكايات تبين أن المتنبي استأثر باهتمام محبيه وعاداته ، وانتشر صيته ، واختلف في قيمته الشعرية ، وكثر الشجار حوله حتى تشكلت حول شعره حركة نقدية أثمرت جملة من الدراسات تعد أساسا في نقد الشعر عند العرب .
أمام هذا الكم الهائل من الدراسات المنجزة حول المتنبي ، وأمام سؤال الاستمرارية ، آثرت أن أتجنب الخوض في شعر المتنبي مباشرة مخافة أن اسقط في أحبولة التكرار والاجترار ، والحالة هذه عن لي بعد لأي وتهيب ، أن يكون موضوعا بحثيا هو الوقوف على بعض الدراسات الحديثة التي قرأت المتنبي بأدوات منهجية مختلفة بغية استنباط الكيفية التي مورست بها القراءة ، واستكناه نتائج هذه القراءات من أجل الحكم على مدى جدتها وتجاوزها للموروث القرائي القديم .
ثم عرض آراء هؤلاء النقاد باعتبارها آراء تمثل جزءا من تاريخ النقد الأدبي في العصر الحديث ، وتعكس لنا ثراء الظاهرة الشعرية عند المتنبي منظور إليها من زوايا متعددة ، وتعكس أيضا أمزجة هؤلاء النقاد وخلفياتهم التي تصبح هي بدورها في حاجة إلى الدراسة والتحليل ، فالمهمة المنوطة بهذا البحث مهمة مزدوجة ، فهو مطالب بان يجيب عن مكونات الخطاب النقدي الذي نشأ حول المتنبي في العصر الحديث وعن طبيعة الدوافع التي حركت هؤلاء النقاد للاهتمام بالمتنبي .
ولكن كيف السبيل إلى الوصول إلي هذا الهدف ، أو ما هو المنهج الملائم لاستخلاص المكونات المنهجية التي توسل بها كل قارئ ليضيء الجواب المعتمة في شعر المتنبي وشخصه ، ثم كيف السبيل للوقوف على اللون المذهبي والنوايا الذاتية لكل ناقد على حدة ؟
إن المنهج الذي سنفحص به هذه الدراسات هو منهج وصفي وتحليلي وانتقائي؛ حيث سنعمد إلى وصف هذه الدراسات من أجل حصر القضايا التي استأثرت باهتمام كل ناقد على حدة وهو يباشر شعر المتنبي أو جزءا من شعره أو شراحه . وفي المستوى التحليلي ، سنسلك ثلاث خطوات نلتزم بها في فصول البحث في المستوى التطبيقي ، بحيث سنركز في البداية على دراسة الأهداف التي أعلنها هؤلاء الدارسون أو أضمروها ، ثم نفحص المتن الشعري الذي ركزوا عليه في دراساتهم ، وأخيرا سنقف على النتائج التي توصلوا إليها لنربطها بطبائع المناهج التي صدروا عنها والتزموا باتباعها .
ولم يكن هدفنا هو قراءة كل الدراسات التي أنجزت في العصر الحديث حول المتنبي ، لذا عمدنا إلى انتقاء عينات ، باعتبار أن كلا منها يمثل منهجها وتوجها ومحورا معنيا ، فاخترنا عينة من منهج تاريخ الأدب ، طه حسين مثلا ، في كتابه " مع المتنبي " ، وأخرى من منهج التحليل النفسي مثلها " يوسف سامي اليوسف
" في مقالته " لماذا صمد المتنبي " ومن المنهج البنيوي ، مثلها " جمال الدين بن الشيخ " بمقالته " تحليل بنيوي تفريعي لقصائد المتنبي " ومن منهج نظرية التلقي مثلها " حسين الواد في دراسته 3 المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب ".
ومن مسوغات هذا الانتقاء ، هو أن كل دراسة من هذه الدراسات تمثل منهجا نقديا مستقلا برؤيته وأدواته ومفاهيمه ، إضافة إلى أن كل دارس ، يتوفر على مشروع نقدي ، شكل فيه المتنبي لبنة أساسية ، بحيث أن تناولهم لشعر المتنبي في أحيان كثيرة عدل من تصوراتهم النقدية ، ومثال ذلك ما سنراه في الفصل الذي عقدناه لطه حسين ، حيث أوصلته دراسته للشك في مصداقية مر آوية الآداب التي كانت تعتبر من أهم المفاهيم التي شيد عليها طه حسين مشروعه النقدي ، وقد وفر المتنبي لبعض الدراسيين مجالا خصبا لإعادة تشكيل الخطاب النقدي العربي القديم ، واستخلاص ثوابته في القراءة ، وتقييم الخطاب النقدي العربي وتعديله وتصحيح بعض الثغرات فيه ، وسنرى ذلك جليا في الفصل الذي عقدنا لحسين الواد.
زيادة على كل هذا ، فهؤلاء الدارسون الذين اخترناهم كمتن للدراسة يوحد بينهم اهتمامهم بالمسألة المنهجية ، فما من أحد منهم ألا وطرح المنهج وإشكاليته كأولوية في النهوض بالدرس الأدبي الحديث ، فبدءا طه حسين الذي ركز في مشروعه النقدي على إثارة المسألة المنهجية كتجاوز للمناهج السائدة في عصره ، ومرورا باليوسف الذي اختار المنهج النفسي محاولا تطبيقه على الشعر الجاهلي ، وشعر الغزل العذري واهتمامه بالتصوف باعتباره تجربة نفسية ، وجمال الدين بن الشيخ الذي تبنى المنهج البنيوي وطوره في كتابه " الشعرية العربية " وفي كتابه " ألف ليلة وليلة أو الكلام الأسير " وأدخل عليه اهتماما بالمتخيل ، ووصولا إلى حسين الواد ، الذي عالج هذه القضية المنهجية بصورة مكشوفة منذ دراسة " البنية القصصية في رسالة الغفران " وفي " تاريخ الأدب مفاهيم ومناهج " وفي دراسة " المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب " .
إن اختيارنا لهذه المناهج الأربعة ، سيمكننا من رصد تطور التفكير في أدب العصر الحديث ، وسيجعلنا نقف على طبيعة تعامل نقادنا المعاصرين مع المناهج الوافدة علينا من الغرب ، بالإضافة إلى أنه سيمنح لنا فرصة تقييم هذه المناهج والحكم على نجاعتها أو فشلها في قراءة تراثنا الشعري ، وهل بالفعل قدمت هذه المناهج شيئا جديدا للدراسات المتنبئية ، أم أنها كررت واجترت ما توصل عليه القدماء بلغة أخرى ؟
غير أن الصعوبة التي اعترضتنا ونحن ننجز هذا البحث هو ندرة الدراسات حول المتنبي ، خصوصا في الجانب النفسي والبنيوي إذ لم نظفر سوى بمقالات أغلبها نشر في أواخر السبعينيات ، ففي حدود علمي لم تنجز دراسة مستقلة حول المتنبي نتبنى إحدى المناهج النفسية ، وإن كانت معظم الدراسات التي تناولت المتنبي من وجهة نظر تاريخ الآداب ، تعرج لماما على بعض العوامل النفسية في شعر المتنبي ، ولكنها كانت إشارات فقط تفتقر إلى التناول الشمولي للظواهر النفسية ، أما بخصوص التناول البنيوي ، فلم أظفر بدراسة خاصة تستجلي الأنساق البنيوي في الديوان ككل ، فقط هناك بعض المقالات التطبيقية ، تعتمد نصوصا مجتزأة من سياقاتها ، وحتى بعض الدراسات التي أعلنت اتخاذها المنهج البنيوي كأداة لتحليل شعر المتنبي ، كانت تخلط التحليل المضموني بالتحليل الشكلي ، ومثال على ذلك ، دراسة يوسف الحواشي " معاني الرفض في الشعر المتنبي " . أو دراسة أيمن محمد زكي العشماوي " قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني " . وتبقى المقالة التي خص بها جمال الدين بن الشيخ ، إحدى قصائد الصبا للمتنبي ، تمثل نسبيا التناول البنيوي لشعره ، ولو أنها اكتفت بتقديم نموذج التحليل على قصيدة واحدة . فقد خرج بتوصيات حول ضرورة معالجة شعر المتنبي في كليته ، وتجاوز الرؤية الانتقائية التي ترتكز على نصوص بعينها دون باقي النصوص الأخرى.
أما بخصوص النموذج التمثيلي لنظرية التلقي ، فلم نظفر سوى بدراسة حسين الواد ، إذ نصيب المتنبي في هذا المنهج لازال في طور البداية ، خصوصا وأن هذا المنهج في الخطاب النقدي العربي الحديث لازال حديث العهد . وفي حدود علمي فالدراسات التي تناولت شروح المتنبي ،نعد منها دراسة رجيس بلاشير " ديوان المتنبي في العالم العربي، " ودراسة " عبد الرحمان شعيب " المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث "، ودراسة لمحي الدين صبحي تحت عنوان " شاعرية المتنبي في نقد القرن الرابع الهجري " غير أن هذه الدراسات لم تتخذ من نظرية التلقي منهجا في تحليل، وتبقى أطروحة الدكتوراة التي أنجزت في مصر تحت عنوان " شراح المتنبي " لطاهر حمروني لم تكن في متناولنا، حتى نتمكن من القيام بموازنة بينها وبين دراسة حسين الواد لنقف على الطرائق اشتغال هذه النظرية عند نقادنا المحدثين.
ونسجل هنا ، أن النصيب الأوفر للدراسات التي أنجزت حول المتنبي كانت من نصيب منهج تاريخ الأدب، حيث انصب الاهتمام على توثيق شعره، وتصحيح نسبه، واستخلاص مذهبه العقائدي، والوقوف على اثر البيئة في تطور شعره.
وسنحاول عبر فصول البحث، أن نقترح بعض الأجوبة عن سبب الاهتمام بالجوانب التاريخية في دراسة المتنبي.
ولتحقيق أغراضنا من هذا البحث في ضوء الإطار المنهجي الذي استقر عليه رأينا، فإننا سوف نقسم البحث إلى أربعة أبواب:
الباب الأول بعنوان، المتنبي من منظور تاريخ الأدب، نموذج طه حسين، قسمناه إلي فصلين: وسنتناول في الفصل الأول مكونات المشروع النقدي عند طه حسين، وقد كان هدفنا من هذا الفصل هو الوقوف على الأسس الفكرية والمذهبية المؤثرة في المشروع النقدي عنده، واستخلاص المفاهيم النقدية التي يشتغل بها، حتى تتمكن من ملاحقة هذه المفاهيم من خلال الدراسة التي خصصها للمتنبي، أما الفصل الثاني ، فقد حللنا فيه كتاب " مع المتنبي " مركزين فيه على إبراز المفاهيم الأساسية عند طه حسين، كمفهوم الجبرية التاريخية، ومفهوم التطور ، والمسار النقدي التقدمي للتاريخ ، ومفهوم الشخصية كمحدد للقيمة الإبداعية في الشعر ، ومفهوم النص / الوثيقة ، ومفهوم القراءة المزدوجة ، والنزعة الانطباعية أو حوار التماهي .
والباب الثاني تحت عنوان" المتنبي من منظور التحليل النفسي" ، يشتمل على فصلين الأول ، بعنوان الأدب والتحليل النفسي . سنعرض فيه العلاقة التي تربط النفس بالإبداع، مركزين فيه على أهم النظريات في التحليل النفسي/ من خلال رواده، كسجموند فرويد، وآدلر ، ويونغ، خصوصا وان المتن الذي عقدنا العزم على تحليله، يتبنى مقولات التحليل النفسي كما تبلورت عند فرويد وأدلر. أما الفصل الثاني من هذا الباب ، فسنحلل فيه مقالتين ؛ إحداهما ليوسف سامي اليوسف والأخرى لعلي كامل ، وذلك انهما أعلنا منذ بداية دراستهما أن الخيار المنهجي الذي سيتبناه هو التحليل النفسي، وسيكون هدفنا من هذا الفصل ، هو استخلاص المفاهيم النفسية وربطها بالنظرية التي تصدر عنها ، ثم البحث في طرق تشغيل هذه المفاهيم، حتى نخلص إلى نوعية النتائج المتوصل إليها عبر هذه الزاوية المنهجية ، ومن خلال تناولنا للمتنبي من وجهة نظر نفسية سنعمد إلى فحص طبيعة المتن الشعري الذي اعتمد عليه كل دارس ، حتى تتمكن من تقديم المستوى البرهاني والاستدلالي في هاتين الدراستين، وسنحاول اقتراح بعض الأجوبة عن أسباب ندرة الدراسات ذات الوجهة النفسية حول شعر المتنبي.
أما الباب الثالث : تحت عنوان " المتنبي في المنهج البنيوي" ، فقد خصصنا الفصل الأول فيه ، لبحث أسس هذا المنهج كما تبلور في أوربا، من خلال رصد أبعاده الجمالية والفلسفية، ومناقشة القضايا الجديدة التي أثارها هذا المنهج ، مثل مفهوم الأدب ، ومفهوم النص ، ومفهوم المؤلف ، وعلاقة الأدب بالمرجع الخارجي وبالفكر ، إضافة إلى المفاهيم الإجرائية لتحليل النصوص الشعرية. أما الفصل الثاني من هذا الباب فسنعمد فيه إلى الوقوف على مستويات التحليل التي طبقها جمال الدين بن الشيخ في دراسته لنص شعري للمتنبي ينتمي إلى مرحلة الصبا. وسنحاول إبراز الخلفيات الثاوية وراء اختياره لهذا النص بالذات ثم بعد ذلك سنناقش نتائج التحليل مبرزين طبيعة الإضافات التي أضافها هذا المنهج للدراسات المتنبئة.
أما الباب الرابع والأخير فقد عنوناه " بالمتنبي من منظور نظرية التلقي " ، سنقسمه هو الآخر إلى فصلين ، حيث سنتناول في الفصل الأول نظرية التلقي من خلال أسسها ومفاهيمها ، مبرزين السياق التاريخي الذي تبلورت فيه ، والأسس الفلسفية التي اعتمدتها من أجل بناء تصور جديد للعلاقة بين الأدب والجمهور المتلقي ، وأخيرا سنقف على أهم المفاهيم التي تميز هذه النظرية عن باقي التصورات السابقة للأدب ، وبذلك سنكون قد استوفينا دراسة المكونات الأساسية للعملية الإبداعية ، التي هي المرسل ، وقد تكفل بدراسة هذا الجانب كل من منهج تاريخ الأدب و التحليل النفسي ، و الرسالة ، التي هي موضوع للمنهج البنيوي ، و المرسل إليه الذي ظل مغيبا في التحليل الأدبي حتى مجيء نظرية التلقي ، التي أعادت له اعتباره ، بصفته المانح للنص كينونته عبر تحيينه و إعادة إنتاجه وفق معايره الجمالية .
| |
|
  | |
الشهبندر
عضو نشيط 
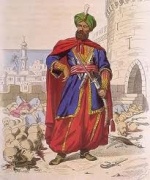
الجنس : 
العمر : 40
 المدينة المنورة المدينة المنورة
التسجيل : 30/09/2011
عدد المساهمات : 141
 |  موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩ موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩  الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:50 pm الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:50 pm | |
|
تـمـهـيـد
سنسعى في هذا الفصل إلى فحص القراءة التي قدمها طه حسين حول المتنبي في كتابه (مع المتنبي). هادفين إلى إبراز طبيعة المنهج الذي اتبعه في الدراسة، مع التركيز على تجلية الطرائق التي اشتغل بها هذا المنهج والآليات المستخدمة فيه، محاولين الوصول إلى طبيعة الصورة التي رسمها منهج تاريخ الأدب للمتنبي. إن هذه العملية ستتم عبر مجموعة من التساؤلات يضطلع هذا الفصل باقتراح أجوبة لها.
إن أولى الأسئلة التي ينبغي طرحها تخص طبيعة منهج تاريخ الأدب من حيث أسسه الفكرية والأيديولوجية وأدواته الإجرائية، ومدى توفره على الكفاية المنهجية، المتمثلة في الكفاية الوصفية والكفاية التفسيرية، هذا ما يخص المنهج، أما الأسئلة المتعلقة بمطبق المنهج، فيمكن أن نجملها فيما يلي :
-
ما هي الدوافع الموضوعية لاختيار منهج تاريخ الأدب كأداة إجرائية لقراءة الأدب العربي ؟
-
هل هناك وعي بالخلفيات الإبستمولوجية والأيديولوجية لهذا المنهج ؟
-
ما مدى الإضافات التي أضافها هذا المنهج وما مدى الكشوفات التي توصل إليها طه حسين من خلاله في دراسته لشعر المتنبي وشخصيته ؟
-
هل استطاع طه حسين أن يدمج هذا المنهج في بنية الثقافة العربية ؟
-
هل استجلاب المنهج أملته ضرورة علمية أم هو استجابة لأيديولوجية الطبقة الليبرالية التي يعتبر طه حسين من أصواتها البارزين ؟
إن إيجاد أجوبة لهذه التساؤلات كفيل بأن يوضح لنا طبيعة العلاقة التي أسسها الدارسون المحدثون مع التراث، وتبين لنا الخلفيات المتحكمة في القراءة وتلقي النص التراثي (المتنبي نموذجا).
ويمكننا أن نضيف بهذا الصدد مسألة أساسية لا تقل أهمية عن القضايا المثارة سابقا، ويتعلق الأمر بقضية المكانة التي تحتلها الدراسة المنجزة حول المتنبي في المشروع النقدي عند طه حسين، خاصة وأن المهتمين بطه حسين لم يولوا أكبر أهمية لدراسته حول المتنبي في حين أنهم ركزوا دراستهم حول كتاب في " الشعر الجاهلي ".
إن اقترابنا من كتاب طه حسين حول المتنبي يقتضي منا وقفة متبصرة حول الإشكال العام المطروح عليه، هذا الإشكال شغل رواد عصر النهضة، إنه الإشكال المنهجي، أي البحث عن صيغة منهجية نقرأ بها التراث العربي في أشكاله المتنوعة. إن نقطة الارتكاز هذه تعتبر حجر الزاوية في المشروع النهضوي الذي حمل على عاتقه مهمة قراءة التراث قراءة تستجيب لمتطلبات العصر وتقاوم التحديات الخارجية. وبالإضافة إلى الهم المنهجي ترد مسألة تأسيس وبناء مشروع نقدي خاص لدى طه حسين كرس له حياته الفكرية والعملية. إذ أن درس التراث ومساءلته من طرف طه حسين لم يكن تزجية للوقت، ولا رغبة في استنساخ التراث وقراءته بعيون تراثية، فالعودة إلى التراث كانت عودة مصلح ينقب عن النقط المضيئة في ماضينا الثقافي لبلورة مشروع يهدف إلى النهوض بالأمة العربية وتعريفها بماضيها وسلكها في الخيط الحضاري. لقد حمل على عاتقه مهمة مزدوجة معرفة الذات والآخر.
سنعرض الآن إلى طبيعة المشروع النقدي عند طه حسين والعناصر الأساسية التي ساهمت في
تأسيس هذا المشروع، حتى نتمكن من وضع دراسة (مع المتنبي) في سياقها الموضوعي، وحتى نتمكن من فهم الأبعاد القصوى لما ورد في الدراسة من آراء نقدية وأحكام تقييمية.
مكونات المشروع النقدي عند طه حسين :
لقد تبلور المشروع النقدي لدى طه حسين ضمن إشكالية كبيرة هي إشكالية النهضة، هذه الإشكالية تقف خلف الإنتاج المتنوع لطه حسين نقدا وإبداعا وفكرا. ولا سبيل إلى فحص هذا المشروع وفهم دلالته التاريخية إلا باستحضار المجال السوسيو-ثقافي الذي تبلور فيه.
إن الخطاب النهضوي سيج بسؤال كبير هو لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا ؟ أمام هذا السؤال العريض والراهن وقفت جل الاتجاهات الفكرية تبحث عن أجوبة، حيث قدم التيار الإصلاحي السلفي جوابا يرمي إلى تحصين الذات من الذوبان في الآخر/الغرب الإمبريالي. إذ من " المعروف أن زمن تبلور الخطاب النهضوي السلفي كان يواكب زمن التسرب الإمبريالي، ومن هنا فإن خطاب السلفيين يتضمن مجادلة مستمرة مع غرب الإمبريالية، لقد اعتبر مثقفو هذا التيار أن الهيمنة الغربية تسعى لإلغاء الهوية الإسلامية، ولهذا يجب محارتها والتصدي لها ".
لذلك نادى زعماء هذا التيار (جمال الدين الأفغاني-محمد عبده) بالرجوع إلى الأصل المتمثل في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، غير متناسين الدعوة إلى الأخذ بالجانب الإيجابي من الحضارة الغربية (العلم والتقنية).
في حين أن التيار الفكري الوطني الليبرالي أخذ بمناهيم العصر واحتذاء النموذج الغربي، وذلك جاء نتيجة للهيمنة الثقافية الموازية للهيمنة العسكرية، حيث أن الذهنية العربية عرفت خلخلة وارتجاجا، فقد انتقل الفكر السياسي الليبرالي، والوضعية، والدارونية، والسان سيمونية، والفكر الاشتراكي إلى مصر والشام، وقد حاول المفكرون الليبراليون إدماج هذه الأفكار ضمن إشكاليتهم الكبرى " إشكالية النهضة ". وبذلك أنتجوا خطابا نهضويا يلغي الحل المقترح من طرف السلفيين معبرين بذلك عن مشروع إصلاحي تقدمه الفئات الاجتماعية الناشئة (الطبقة البورجوازية).
وأثناء صياغتهم لهذا الخطاب النهضوي التجؤوا إلى مفاهيم التراث الليبرالي:
" الجانب الفلسفي / العقلانية والوضعية.
الجانب السياسي / اللائكية والديمقراطية.
الجانب الفلسفي / الحرية ومبدأ المنافسة الفردية
الجانب الفلسفي / تمجيد الإنسان والسعي نحو المنفعة الدنيوية ".
إن ما كان يميز هذه المرحلة هو الصراع الأيديولوجي بين هذه التيارات، فبالرغم من أن السؤال واحد، فإن الأجوبة جاءت مختلفة باختلاف المواقع والمواقف السياسية. فما هو الموقع الذي احتله طه حسين داخل هذا الصراع ؟
إن انتماء طه حسين للريف المصري، ومروره بحياة قاسية في وسط تسوده الخرافة والأساطير والتقاليد والتي كانت سببا في إفقاده بصره، بالإضافة إلى سلطة المؤسسات التقليدية (الكتاب، الأزهر)، كل هذه العوامل ولدت في نفسه شعورا بالمرارة وإحساسا عميقا بالتخلف. غير أن انتقاله إلى القاهرة وانتسابه إلى الجامعة سنة 1908، جعله يطلع على مناهج جديدة، وعلى ثقافة ذات أصول غربية، بالإضافة إلى أنه انخرط في الصحافة التي كانت آنذاك تذكي الصراعات السياسية والأيديولوجية. وقد وجد نفسه يميل إلى أفكار حزب الأمة المتكون من طبقة الأعيان بالرغم من أنه لا يوافق موقعه الطبقي، لأن أفكار الحزب الليبرالية فتحت أمامه طريقا بعث فيه الأمل وجعله يقطع كل صلة بموروثة السابق، فهو قد قطع صلته بالريف والكتاب والأزهر والأسرة التقليدية. وقد رأى طه حسين أن مشروع الحزب كفيل بأن يحل إشكالية النهضة، لا سيما وأن الحزب ركز على التعليم والعلم .
كمؤسسة أساسية ليرفع إليه العامة، ولأنه كان يرى أن التخلف مرتبط بالجهل. " وبما أن طه حسين لم يكن ينتمي إلى طبقة الأعيان - حزب الأمة - فإنه سيسقط أحيانا في التردد بين إحساسه الصادق وانتمائه الطبقي للحزب الوطني الذي يتشكل من عامة الشعب وبين انتمائه الفكري لحزب الأمة، لقد كان يحمل طه حسين معه هذه المعادلة منذ اتصاله بالكتاب، وستكون جزءا أساسيا في صياغة كتابته النقدية التي ستجد أرضها في التراث العربي وفي المفاهيم والأفكار اللبرالية ".
ويمكننا أن نسجل بهذا الصدد أن الازدواجية تعتبر خصيصة مهيمنة في المشروع الفكري والنقدي لطه حسين، فكيف تجلت هذه الازدواجية في كتاباته؟
| |
|
  | |
الشهبندر
عضو نشيط 
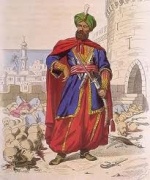
الجنس : 
العمر : 40
 المدينة المنورة المدينة المنورة
التسجيل : 30/09/2011
عدد المساهمات : 141
 |  موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩ موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩  الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:51 pm الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:51 pm | |
|
المتنبي من منظور تاريخ العرب
مكونات المشروع النقدي عند طه حسين :
لقد تبلور المشروع النقدي لدى طه حسين ضمن إشكالية كبيرة هي إشكالية النهضة، هذه الإشكالية تقف خلف الإنتاج المتنوع لطه حسين نقدا وإبداعا وفكرا. ولا سبيل إلى فحص هذا المشروع وفهم دلالته التاريخية إلا باستحضار المجال السوسيو-ثقافي الذي تبلور فيه.
إن الخطاب النهضوي سيج بسؤال كبير هو لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا ؟ أمام هذا السؤال العريض والراهن وقفت جل الاتجاهات الفكرية تبحث عن أجوبة، حيث قدم التيار الإصلاحي السلفي جوابا يرمي إلى تحصين الذات من الذوبان في الآخر/الغرب الإمبريالي. إذ من " المعروف أن زمن تبلور الخطاب النهضوي السلفي كان يواكب زمن التسرب الإمبريالي، ومن هنا فإن خطاب السلفيين يتضمن مجادلة مستمرة مع غرب الإمبريالية، لقد اعتبر مثقفو هذا التيار أن الهيمنة الغربية تسعى لإلغاء الهوية الإسلامية، ولهذا يجب محارتها والتصدي لها ".
لذلك نادى زعماء هذا التيار (جمال الدين الأفغاني-محمد عبده) بالرجوع إلى الأصل المتمثل في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، غير متناسين الدعوة إلى الأخذ بالجانب الإيجابي من الحضارة الغربية (العلم والتقنية).
في حين أن التيار الفكري الوطني الليبرالي أخذ بمناهيم العصر واحتذاء النموذج الغربي، وذلك جاء نتيجة للهيمنة الثقافية الموازية للهيمنة العسكرية، حيث أن الذهنية العربية عرفت خلخلة وارتجاجا، فقد انتقل الفكر السياسي الليبرالي، والوضعية، والدارونية، والسان سيمونية، والفكر الاشتراكي إلى مصر والشام، وقد حاول المفكرون الليبراليون إدماج هذه الأفكار ضمن إشكاليتهم الكبرى " إشكالية النهضة ". وبذلك أنتجوا خطابا نهضويا يلغي الحل المقترح من طرف السلفيين معبرين بذلك عن مشروع إصلاحي تقدمه الفئات الاجتماعية الناشئة (الطبقة البورجوازية).
وأثناء صياغتهم لهذا الخطاب النهضوي التجؤوا إلى مفاهيم التراث الليبرالي:
" الجانب الفلسفي / العقلانية والوضعية.
الجانب السياسي / اللائكية والديمقراطية.
الجانب الفلسفي / الحرية ومبدأ المنافسة الفردية
الجانب الفلسفي / تمجيد الإنسان والسعي نحو المنفعة الدنيوية ".
إن ما كان يميز هذه المرحلة هو الصراع الأيديولوجي بين هذه التيارات، فبالرغم من أن السؤال واحد، فإن الأجوبة جاءت مختلفة باختلاف المواقع والمواقف السياسية. فما هو الموقع الذي احتله طه حسين داخل هذا الصراع ؟
إن انتماء طه حسين للريف المصري، ومروره بحياة قاسية في وسط تسوده الخرافة والأساطير والتقاليد والتي كانت سببا في إفقاده بصره، بالإضافة إلى سلطة المؤسسات التقليدية (الكتاب، الأزهر)، كل هذه العوامل ولدت في نفسه شعورا بالمرارة وإحساسا عميقا بالتخلف. غير أن انتقاله إلى القاهرة وانتسابه إلى الجامعة سنة 1908، جعله يطلع على مناهج جديدة، وعلى ثقافة ذات أصول غربية، بالإضافة إلى أنه انخرط في الصحافة التي كانت آنذاك تذكي الصراعات السياسية والأيديولوجية. وقد وجد نفسه يميل إلى أفكار حزب الأمة المتكون من طبقة الأعيان بالرغم من أنه لا يوافق موقعه الطبقي، لأن أفكار الحزب الليبرالية فتحت أمامه طريقا بعث فيه الأمل وجعله يقطع كل صلة بموروثة السابق، فهو قد قطع صلته بالريف والكتاب والأزهر والأسرة التقليدية. وقد رأى طه حسين أن مشروع الحزب كفيل بأن يحل إشكالية النهضة، لا سيما وأن الحزب ركز على التعليم والعلم .
كمؤسسة أساسية ليرفع إليه العامة، ولأنه كان يرى أن التخلف مرتبط بالجهل. " وبما أن طه حسين لم يكن ينتمي إلى طبقة الأعيان - حزب الأمة - فإنه سيسقط أحيانا في التردد بين إحساسه الصادق وانتمائه الطبقي للحزب الوطني الذي يتشكل من عامة الشعب وبين انتمائه الفكري لحزب الأمة، لقد كان يحمل طه حسين معه هذه المعادلة منذ اتصاله بالكتاب، وستكون جزءا أساسيا في صياغة كتابته النقدية التي ستجد أرضها في التراث العربي وفي المفاهيم والأفكار اللبرالية ".
ويمكننا أن نسجل بهذا الصدد أن الازدواجية تعتبر خصيصة مهيمنة في المشروع الفكري والنقدي لطه حسين، فكيف تجلت هذه الازدواجية في كتاباته؟
1- التكوين الفكري المزدوج لطه حسين :
تتجلى ازدواجية التفكير لدى طه حسين، في علاقته بحزب الأمة، حيث لم يعتنق أفكاره السياسية لأنه حزب الأعيان، بل اقتصر منه على جانب التحرر الفكري وبقي بعاطفته مع الحزب الوطني الذي يمثل فئات الشعب. وقد كان لطفي السيد مثله الأعلى، لأنه كان يمثل الشخصية النموذجية في عصره لأنه كان مثقفا عقلانيا وتنويريا، يجمع بين عدة ثقافات (إسلامية خاصة الفلسفة، يونانية، أوربية).
إن تأثير لطفي السيد على طه حسين هو ما حدا به إلى أن يصوغ مشروعه وفق تصورات وأطروحات عقلانية، تمتع مفاهيمها من الفكر الليبرالي .
وبالإضافة إلى ازدواجية الفكر السياسة تبرز ازدواجية أخرى تتعلق بمفهوم القراءة عنده، مفهوم القراءة عنده تبلور ضمن أطر مرجعية كلاسيكية وأخرى حديثه، فالإطار المرجعي القديم لقراءاته هو مؤسسة الأزهر ممثلة في شخصية أستاذة حسين الموصفي صاحب كتاب " الوسيلة الأدبية "، فهذا الأخير علمه كيف يقرأ النص العربي وكيف يفهمه ويتمثله في نفسه ويحاول محاكاته. أما الإطار المرجعي الحديث فيتمثل في الجامعة متجسدا في أساتذته (المستشرقين) خاصة المستشرق الإيطالي " كارلونلينو "، الذي علمه كيف يستنبط الحقائق من النص وكيف يصوغها ليقرأها الناس فيفهمونها ويجدون فيها شيئا ذا بال.
إن الإطار المرجعي القديم يوفر لطه حسين مستوى الفهم أي فهم اللغة التي كتب بها النص، ومستوى التمثل عن طريق إدماج النص في ذات القارئ من خلال تذوق النص والإحساس بجماليته، ثم أخيرا مستوى المحاكاة أي تقليد النص لكسب تقنية عالية في الكتابة والإنشاء (الأسلوب).
أما الإطار المرجعي الحديث، فقد أسهم في إبراز الحقائق التاريخية المستنبطة في النص، وقراءة النص في سياقه الخارجي.
إن هذا التراوح بين أطر مرجعية متفاوتة في الزمن والمكان والهدف تعكس النزعة الانتقائية لدى طه حسين، وقد تشكل هذا المنزع الانتقائي ضمن المكونات الفكرية والأدبية عنده، فما هي هذه المكونات والمرجيات الفكرية ؟
2- المرجعيات الفكرية عند طه حسين :
لقد حمل طه حسين على عاتقه مهمة إنجاز مشروع حضاري ضخم، يسعى إلى تنوير الذهنية العربية، وتجاوز التصورات المحافظة الموروثة.
والاضطلاع بهذه المهمة الحضارية تكتفه صعوبات ومخاطر، لذا كان لزاما على طه حسين أن يحتمي بنموذج فكري مغاير، هذا النموذج سيجده في الغرب.
فبعد عودة طه حسين من فرنسا سنة 1919، وبعد أن أحرز الفكر الليبرالي في مصر مكتسبات ضد الفكر المحافظ، سينادي "بأن الحضارة الأوربية اعتمدت في نهضتها على الحضارة الإغريقية الرومانية والـديـانـة المسيحية، ويجدر بالنهضة العربية أن تعتمد على الحضارة الإغريقية والرومانية والديانة الإسلامية ".
نسجل في البدء أن طه حسين يستحضر النموذج الغربي كمنطلق للتطور والتقدم، ويرى بأن المجتمع ينبغي أن تؤول قيادته للعلماء، ولم ينحصر النموذج الغربي لدى طه حسين في الغرب الحديث، بل رجع به إلى الأصول الأولى التي شكلت الحضارة الغربية، الحضارة الإغريقية، فأصول الغرب الحديث وضعها اليونان، حيث ابتكر هؤلاء العلم كمباحث قائمة على منهج عقلاني وكنظام من المعارف المجردة، وابتكروا السياسة وفصلوها عن الغيب، فجعلوا مصدر السلطة هو الجماعة البشرية المعنية (أي النظام الديمقراطي). في حين أن الشرق لم يعرف سوى نظام الحكم الذاتي (الاستبداد).
وفي إطار تنفيذ هذا المشروع عكف طه حسين على تدريس التاريخ اليوناني والروماني في الجامعة لمدة سنوات، وألف كتابا عن " آلهة اليونان " سنة 1919، وفي سنة 1921 ترجم كتابا لأرسطو " نظام الاثينين ".
بالإضافة إلى هذه المكونات، تأتي الفلسفة الوضعية كإطار مرجعي لتصورات طه حسين حول الأدب، وإن لم يتصل طه حسين بهذه الفلسفة مباشرة، فإنه قد تأثر بمجموعة من النقاد الغربيين يرتكزون على أسس هذه الفلسفة، وأبرز هؤلاء النقاد هم : هيبوليت تين وسانت بوف وغوستاف لانسون و جول لوميتر .
لقد كانت الوضعية في النصف الثاني من القرن 19 تعتبر النص الأدبي وثيقة، أي أن النص كان يدرس في وظيفته التي تحيل على المرسل، وقد مثل " هيبوليت " تصور الفلسفة الوضعية في الأدب، بالإضافة إلى اتخاذه البيولوجيا كعلم نموذجي، يقول " لماذا تدرسون المحارة، إذا لم يكن ذلك لتصور الحيوان ؟ وبنفس الشكل إنكم لا تدرسون الوثيقة إلا للتعرف على الإنسان "، وإذا كان تاريخ الأدب الوضعي لم يعر النص الأدبي، باعتباره عنصرا من مقام تواصلي، إلا أهمية قليلة، فإن ما أعاره من ذلك للمتلقي أقل، فالاهتمام بالمرسل وحده يعني نفي المتلقي. وقد كانت فلسفة باروخ سبنوزا وفريديريك هيجل الشمولية وراء مفهوم التاريخ الأدبي العلموي لدى تين * فأراد هذا الأخير " وضع تفسير كامل شامل لوجود وصيرورة الأدب، يربط الوقائع الأكثر خصوصية بوقائع عامة، وباكتشاف مجموع القوانين التي تعبر من هذا المجال، عن منطقية العالم "، ثم يأتي بعد تين " فردنياند برونتير " ليناهض المذهب الطبيعي، مقتبسا نموذجا من العلوم البيولوجية، ومن الداروينية على وجه الخصوص، ويتم تشبيه الأشكال الأدبية عنده بأصناف تولد، وتختلف وتتعقد، وتصل إلى القمة ثم تنحدر وتموت. وعلى الناقد أن يرصد هذا المنحى التطوري الذي يتحكم في النجاح الفردي. بعد برونتير، سيظهر مؤرخ أدبي تتلمذ على يديه إنه غوستاف لاسنون، الذي سيشجب التصور العلماوي عند تين والنظري عند برونتير. يقول " لا يبني علم على نموذج علم آخر إذ يرتبط تقدم العلوم باستقلاليتها المتبادلة التي تسمح لكل علم بالانصياع لهدفه، ولكي يتسم تأريخ الأدب بشيء من العلمية يجب أن يبدأ بالامتناع عن إعطاء صورة ساخرة عن العلوم الأخرى، مهما كانت ". ولقد وضع لانسون برنامجا واسعا للبحث يضم مراحل مختلفة تخضع لترتيب إجباري هي : إعداد النص الأصلي، تأريخ النص كاملا وتأريخ مختلف أجزائه، مقابلة النسخ وتحليل المتغيرات، البحث عن الدلالة الأولية " المعنى الحرفي للنص "، وكذا الدلالات المنزاحة عنه (المعنى الأدبي للنص)، تحليل الخلفية الفلسفية والتاريخية للنص، (منظور إليه، والحالة هذه، "في علاقته مع مؤلفه وعصره " وليس نتيجة إسقاط تصورات الباحث المعاصر)، دراسة المراجع والمصادر، نجاح العمل الأدبي وتأثيره، تجميع المؤلفات التي يمكن أن تكون متقاربة بشكلها أو محتواها دراسة الأعمال الضعيفة والمنسية حتى يتسنى تقويم أصالة الأعمال العظيمة، التفاعل بين الأدب والمجتمع .
ويبدو أن لانسون كان أكثر تأثيرا على طه حسين من النقاد الآخرين، غير أنه لا ينبغي أن يفوتنا أن نذكر تأثير سانت بوف، وجول لومتير حول النزعة الانطباعـية والتأثيرية لدى طه حسين.
الكتابات التأسيسية والاهتمام بالمنهج :
من خلال استعراضنا للمكونات الفكرية لطه حسين تبدى أن هذه الأطر زودته بحس منهجي، هذا الحس وهذه الضرورة المنهجية تجلت في الكتابات النقدية التأسيسية لديه. وما يقصد بالكتابات التأسيسية هو الكتابات التي كان منشغلا فيها بالبحث عن منهج للقراءة يخالف به المناهج السائدة، وتبدأ هذه الكتابات لكتابة بتجديد ذكرى أبي العلاء " (1915)،مرورا ب " حديث الأربعاء "، وصولا إلى كتاب " في الشعر الجاهلي " ( )، وتمثل هذه الكتابات خلاصة الصراع حول تكريس منهج علمي لمقاربة الظاهرة الأدبية.
إن هذا الانشغال بقضية المنهج أملته ضرورة تاريخية، حيث أن الجدل اشتد حول المنهج منذ فترة مبكرة من بداية القرن 20 ، وقد مثل الزيات وجورجي زيدان ومصطفى صادق الرافعي، طه حسين أقطاب الصراع حول مسألة المنهج، وكان لكل واحد منهم كمثله الخاص.
يبدو من خلال مؤلفات هؤلاء المؤرخين للأدب أن هناك تفاوتا بارزا حول تمثل مسألة المنهج، فقد عرض كل واحد منهم طريقته الخاصة في التأريخ للأدب، إذن قسم جورجي زيدان حسن والزيات الأدب إلى عصور سياسية، في حين أن الرافعي رفض هذا التقسيم وأبدله بالتقسيم حسب الأغراض الأدبية، واعتبر التقسيم السياسي نقلا عن المستشرقين أما طه حسين فقد تبنى التقسيم وفق المدارس الفنية .
إن هذا التضارب في الآراء حول المنهج الملائم لتقسيم الأدب والتأريخ له، يستبطن موقفا غامضا حول مسألة المنهج، لاسيما وأن الهم المنهجي لا يزال في طور المخاض، وما يجلي هذا الغموض هو أن كلمة " منهج Méthode " لم ترد عند الرافعي وزيدان والزيات، إذ استعلموا مكانها كلمتي " الطريقة و " الخطة "، ولم يستعمل الزيات كلمة " منهج " إلا بعد مضي خمسة وأربعين عاما من ظهور الطبعة الأولى لعمله . ويبدو أن طه حسين هو الذي استعمل كلمة " منهج " وخصص لها مواطن في كتابه " في الأدب الجاهلي ".
" لقد كانت قضية المنهج، فيما يبدو، واحدة من أهم القضايا التي شغلت ذهن طه حسين على اعتبار أن الثورة المنهجية، من شأنها تجديد العقل وتحريره وليس تجديد وسائل البحث وأدواته فقط. ولعل هم الحداثة ووعي طه حسين بأهمية المنهج هو الذي يفسر لنا هذا الالتحام العميق الذي أبداه طه حسين بالمنهج الديكارتي " .
ولقد تمثلت مظاهر الوعي بالمنهج عند هؤلاء الرواد في جوانب عدة، من
بينها أنهم اعتبروا " تاريخ الأدب " علما جديدا لم يسبق للعرب القدامى أن عرفوه، إذ لا يمكن مقارنته بكتب التراجم والطبقات لأن هذه الأخيرة تفتقر إلى البحث عن العلائق والتحولات.
" فهي أخبار مفردة غير مرتبطة لا تظهر ما بين الشعراء أو الكتاب من علاقة في الصناعة والغرض والأسلوب، ولا تذكر ما عزا النظم والنثر من تحول وتقلب ".
وقد قدموا تبريرات حول اختياراتهم المنهجية، حيث بين زيدان أن طريقته تمكن القارئ من الاطلاع على التأثيرات السياسية في الأدب والعلوم، وفهم السيرورة التي يتطور بها الأدب عبر العصور التاريخية. أما الرافعي، فقد بين أن طريقته في التقسيم إلى أغراض فنية هي أكثر تلاؤما مع طبيعة الأدب العربي، أما منهج طه حسين في التقسيم إلى مدارس فنية فهو عنده عظيم الفائدة، لأنه يعلم الطلاب كيف يكتشفون النصوص، وكيف يحققونها ويقرؤونه، فيفهمونها على وجهها ويفطنون إلى مظاهر الجمال الفني فيها، ناهيك على أنه يؤدي إلى نتائج جليلة " هي إلى الثورة الأدبية أقرب منها إلى كل شيء ".
إن هذه المظاهر إن دلت على شيء، فإنما تدل على أن قضية المنهج أصبحت ضرورة ملحة عند العرب المحدثين من العصور الحديثة، وقد كان وراء هذا الوعي المنهجي عوامل منها ما يرتبط بوضعية الدرس الأدبي في بداية القرن، ومنها ما يرتبط بالانفتاح على الغرب.
ذكرنا سابقا أن تمثل المنهج لدى الرواد اكتنفه بعض الغموض والتضارب في الآراء وقد كان مرد ذلك كله إلى أن هذا الوعي المنهجي جاء في لحظة مخاض، بالإضافة إلى تنوع المشارب الثقافية لكل من هؤلاء الرواد، واختلاف انتماءاتهم الطبقية والدينية والسياسية، دون أن ننسى الإشارة إلى تعقد مسألة التاريخ الأدبي التي لازالت مطروحة للنظر وإعادة النظر من طرف أحدث النظريات المعاصرة (نظرية التلقي نموذجا). لغياب نظرية عربية تؤرخ الظواهر بصفة عامة.
إذا كان طه حسين كما سلف الذكر من أبرز من أثار مشكلة المنهج في التأريخ الأدبي، يمكننا أن نتساءل عن الكيفية التي تجلى بها وعيه المنهجي في كتاباته التأسيسية ؟ وسنحاول إضاءة هذه الكيفية عبر وقوفنا عند المحطات الهامة من مشروعه النقدي المتمثل بالخصوص في " تجديد ذكرى أبي العلاء " و " حديث الأربعاء " و " في الأدب الجاهلي ". وصولا إلى كتابه المخصص للمتنبي.
| |
|
  | |
الشهبندر
عضو نشيط 
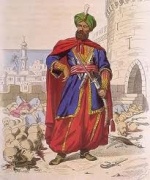
الجنس : 
العمر : 40
 المدينة المنورة المدينة المنورة
التسجيل : 30/09/2011
عدد المساهمات : 141
 |  موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩ موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩  الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:52 pm الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:52 pm | |
|
- الإشكال المنهجي من خلال " تجديد ذكرى أبي العلاء ".
يعتبر كتاب " تجديد ذكرى أبي العلاء " خلاصة المفاهيم النقدية عن طه حسين في مرحلته المبكرة، وقد امتدح مفاهيمه من التصورات الكلاسيكية النقدية المتمثلة في منهج أستاذه المرصفي، ومن التصورات الحديثة المتمثلة في منهج الجامعة، وبالإضافة إلى أن الكتاب يعتبر محصلة فكرية لطه حسين في مرحلة من مراحل حياته النقدية، فإنه كتاب يؤرخ للحركة الأدبية في مصر، ويتسم بالجدة على المستوى المنهجي، إذ وضعه صاحبه على خطة مرسومة من القواعد والخطط التي يتخذها الأوربيون أساسا لما يكتبون في تاريخ الأدب.
ولقد اتضحت معالم الصراع في الكتاب بين نوعين من الثقافات المتعايشة داخل ذهن طه حسين، هذا الصراع سيولد لديه وعيا بالإشكال المنهجي. فكيف عبر عن هذا الإشكال ؟
يعلن طه حسين عن أسس المنهج التي سيعتمدها، مفصلا في تبيان الفروق بين المنهج القديم والمنهج الحديث، موضحا مزايا كل من الطريقتين، يقول بخصوص منهج المرصفي " مذهب الأستاذ المرصفي نافع النفع كله إذا أريد تكوين ملكة الكتابة وتأليف الكلام وتقوية الطالب في النقد وحسن الفهم لآثار العرب، وليس يريد الأستاذ أكثر من ذلك ، ولكن هذا المذهب وحده لا يكفي لإجادة البحث عن الآداب وتاريخها على المنهج الحديث " أما المنهج الحديث فإنه " نافع النفع كله لاستخراج نوع من العلم لم يكن لنا به عهد مع شدة الحاجة إليه، وهو تأريخ الآداب تاريخا يمكننا من فهم الأمة العربية خاصة والإسلامية عامة فهما صحيحا ، حظ الصواب فيه أكثر من حظ الخطأ ، ونصيب الوضوح فيه أولى من نصيب الغموض" .
بعد هذا التميز يقف طه حسين على توضيح خاصيات كلا المنهجين ، مبرزا السمة الموضوعية التي يتسم بها المنهج الحديث ومؤكدا على الطابع التأثري للمنهج القديم، يقول : " كره المنهج القديم إلى أبا العلاء ، وأزال المنهج الحديث من نفسي هذا الكره، ووقفني مع بعض الشعراء المحدثين والمتقدمين موقف الرجل الحر، لا يستهويه حب ولا يصرفه بغض وإنما المجيد والمسيء عنده سواء في الخضوع لقوانين البحث ".
وبالرغم من الوعي بحدود كلا المنهجين فإن طه حسين لم يقم قطيعة مع المنهج القديم وذلك مسايرة لنزعته التوفيقية ، يقول " ولست أزعم أنا لسنا في حاجة إلى درس الآداب على المنهج القديم ، بل أنا نقول إنا في حاجة إلى المنهجين معا، في حاجة إلى المنهج القديم لنقوي في أنفسنا ملكة الإنشاء وفهم الآثار العربية التليدة، في حاجة إلى المنهج الحديث لنحسن استنباط التاريخ الأدبي من هذه الآثار".
2- المنزع العلمي عند طه حسين ( ذكرى أبي العلاء ) :
لقد كان طه حسين يحاور المناهج السائدة في عصره ، محاولا تجاوزها باختياره للمنهج الحديث الذي اختطه الغربيون ، والمتمثل في المنهج التاريخي ، الذي يعنى بتتبع حياة النصوص من خارجها وتوثيقها علميا، لاستخلاص التاريخ الأدبي منها ومعرفة الأمة من خلالها، ولقد تحري طه حسين من كتابه أن يخرجه إخراجا علميا صرفا ، وهذا الإخراج كان على حساب النص المدروس، ولم يكن هذا المنزع العلمي في درس الأدب بدعا فهو من آثار الفلسفة الوضعية التي هيمنت في القرن 19، حيث نادى Taine و Brunitière بعلمنة الأدب ودرسه وفق نماذج العلوم التجريبية (علوم الأحباء).
إن طه حسين يعتبر كتابه حول أبي العلاء خطوة رائدة في المنهج التاريخي المرتكز على أسس علمية دقيقة ، تمثلت هذه النزعة في خطة مرسومة منذ البداية تهدف إلى تعميق الحس المنهجي أكثر من اهتمامها بقراءة المعري قراءة تأويلية.
يذكر طه حسين بصدد تقريظ كتابه بأنه لا يعرف " كتابا ظهر على هذا النحو من البحث ، وربما لا أغلو إن قلت إني لا أعرف كتابا في الآداب العربية قد وضعه صاحبه على قاعدة معروفة وخطة مرسومة من القواعد والخطط التي يتخذها علماء أوربا أساسا لما يكتبون في تاريخ الآداب ن فأما أنا فقد وضعت لهذا الكتاب خطة رسمتها رسما ظاهرا في هذا التمهيد الذي يلقاك بعد الفراغ من هذه الكلمة وتشددت في اتباع هذه الخطة ، فلم أهملها ولم أشد عن أصل من أصولها حتى كاد الكتاب يكون نوعا من المنطق أو هو بالفعل منطق تاريخي وأدبي ليس فيه حكم إلا وهو يستند إلى مصدر، و لا نتيجة إلا وهي تعتمد على مقدمة ، وقد بذلت الجهد في استقصاء حظها من الصحة ، ولست أزعم أن نتائج هذا الكتاب كلها حق من غير شك، ولكني أعتقد أن إصابتها عندي راجحة ، وإنها إلى اليقين أقرب منها إلى الشك. "
إن هم طه حسين بالأساس هم منهجي، وذلك أن درس الأدب عنده لم يكن ليبحث عن رؤى مغايرة، وإنما كان هاجسه هو ترسيخ قواعد المنهج في الدرس الأدبي ، وقد تنوعت الروافد التي استقى منها منهجه، وكان لعلم الاجتماع تأثير بالغ في تصوراته المنهجية، فطه حسين يعتبر الظواهر الثقافية ومنها الأدب، ظواهر اجتماعية، ذلك لأن الطبيعة الاجتماعية للإنسان ترد كل الأشكال الثقافية التي ينتجها إلى عصره وبيئته غير أن العلاقة بين الظواهر الاجتماعية والظواهر الثقافية لا تتسم عنده بالجدل، إذ تتحول فقط إلى " حتمية اجتماعية مبسطة " ، وقد تجلت هذه الحتمية المبسطة من خلال كتاب " تجديد ذكرى أبى العلاء " ، من خلال مبدأ " الجبر التاريخي " الذي آمن به ابن خلدون وبعده مونتسكيو . وهو يعني عند طه حسين " أن الحياة الاجتماعية إنما تأخذ أشكالها المختلفة ، وتنزل منازلها المتباينة، بتأثير العلل والأسباب التي لا يملكها الإنسان ، ولا يستطيع لها دفعا ولا اكتسابا " .
إن النظرة المستقلة للإنسان تعتبر أمرا مستحيلا، فالعالم يتألف من أشياء يتصل بعضها ببعض ، ويؤثر بعضها في بعض : فالإنسان بأطواره وآثاره الفكرية " نتيجة لازمة وثمرة ناضجة لطائفة من العلل" اشتركت في تأليف مزاجه وتصوير نفسه، من غير أن يكون له عليها سيطرة أو سلطان، وينتج عن هذا التصور للأشياء أن يصبح أبو العلاء ثمرة من العلل " عمل على إنضاجها الزمان والمكان، والحال السياسية والاجتماعية بل الحال الاقتصادية ... ولسنا نحتاج إلى أن نذكر الدين ، فإنه أظهر أثرا من أن نشير إليه " . فالإنسان وفق هذا التصور جزء من حركة التاريخ وحركة التاريخ حركة جبرية ليس للاختيار فيها مكان.
لقد استقى طه حسين هذه المفاهيم حول علاقة الأدب بالظواهر الاجتماعية من علماء الاجتماع دوركهايم على سبيل المثال، الذي يركز بالأساس على أن الفرد ثمرة للمجتمع ، ومن ابن خلدون الذي ركز على العلل المتحكمة في سيرورة التاريخ ، وتأثر أيضا بدروس المستشرق الإيطالي كارلونيللو ، فقد كان لهذا الأخير أثر بارز على طه حسين الذي يقول في حق أستاذه " لأول مرة تعلمنا أن الأدب مرآة لحياة العصر الذي ينتج فيه لأنه إما أن يكون صدى من أصدائها وإما أن يكون دافعا من دوافعها فهو متصل بها على كل حال ، وهو مصور لها على كل حال، ولا سبيل إلى درسه وفقهه، إلا إذا درست الحياة التي سبقته فأثرت في إنشائه، والتي عاصرته فتأثرت به وأثرت فيه ".
يسعى طه حسين سعيا إلى تجاوز التصورات السابقة بغية تأسيس تصور جديد بنبني على فهم الأمة العربية الإسلامية وفق منهج تاريخي. ولقد توسل لذلك بلغة النفي والإثبات لإنجاز عملية الهدم والبناء. " وربما كانت هذه اللغة ، النفي والإثبات ، من أهم مؤسسات الكتابة النقدية عند طه حسين ، لأننا سنلاحظها في كتاباته اللاحقة بشكل أو بآخر ، وتحاول هذه اللغة أن تشعرنا بضرورة التحول أو " التغير " الذي كان يهفو إليه منذ بداية حياته الفكرية، وربما غلب على هذا الشعور الجانب النظري الطموح والمثالي أحيانا، والذي يستمد قوته من الاتجاه الليبرالي الذي نشأت فيه تلك الدوافع ... ولذلك كانت قراءته للنص العربي أحيانا شديدة السرعة بغية الوصول إلى ذلك القصد المنهجي وكأنما كان يقفز بنظراته الطموحة إلى حقائق يسميها " علمية ".
نستخلص مما سبق أن طه حسين ظل يصارع المناهج السابقة ( التي كانت في الأزهر ) التي كانت تقف عند مستوى الشرح اللغوي، محاولا بذلك تأصيل المنهج التاريخي الذي أخذ عن المستشرقين ومؤرخي الأدب في الغرب. وقد طبق هذا المنهج على أبي العلاء مركزا على وصف حياته وصفا دقيقا. لكن الملاحظ أن القراءة القديمة للنص ظلت مصاحبة لطه حسين ، وقد تمثلت هذه القراءة الكلاسيكية في وقوفه على بعض القضايا اللغوية والنحوية مع إيراد أحكام تكنفها عبارات ذوقية ، ناهيك عن اختزاله لبعض القصائد في تعاليق موجزة على غرار ما كان يفعله شيوخ الأزهر. وإن دل هذا التعايش بين القديم والحديث من خطاب طه حسين النقدي فإنما يدل على ازدواجية التفكير عنده، هذه الازدواجية مبعثها أن البنيات الاجتماعية لا يزال يتعايش فيها القديم والحديث ، إذ لم تحدث في المجتمع قطيعة بين البنيات الموروثة والفكر الليبرالي الداعي إلى حركية التفكير وهدم البنى السائدة ، لذلك وجدنا الطموح النظري عند طه حسين يتعثر أمام الممارسة النقدية التي أعطتنا قراءة تبريرية لنص أبى العلاء وعجزت هذه القراءة على استنطاق النص العلائي ومساءلته بغية كشف عوالمه أبي العلاء المعري.
| |
|
  | |
الشهبندر
عضو نشيط 
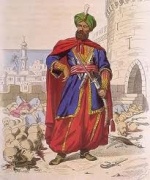
الجنس : 
العمر : 40
 المدينة المنورة المدينة المنورة
التسجيل : 30/09/2011
عدد المساهمات : 141
 |  موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩ موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩  الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:53 pm الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:53 pm | |
|
3- " حديث الأربعاء " وتجليات منهج تاريخ الأدب :
يتكون " حديث الأربعاء " من ثلاثة أجزاء خصصها لدراسة الأدب العربي من الجاهلية إلى العصر الحديث ، حيث خصص الجزء الأول للشعر الجاهلي وصدر الإسلام، والجزء الثاني للعصر العباسي ، أما الجزء الثالث فقد خصصه للأدب الحديث. إن هذا الترتيب يوضح رغبة طه حسين في دراسة الأدب العربي وفق المنهج التاريخي، بالرغم من أن إذاعته لهذه الأحاديث في مرحلتها الأولى لم يراع فيه طه حسين الترتيب التاريخي، حيث أنه نشر أول مقالة من أحاديثه في جريدة السياسة سنة 1922 حول الترجمة التي قام بها حافظ إبراهيم لكتاب " البؤساء " لفكتور هيجو ، ولم ينشر هذه المقالة ضمن أحاديثه بل أدرجها في الكتاب الذي خصصه لشوقي وحافظ. بالإضافة إلى هذا، فطه حسين قد ابتدأ بالأحاديث المتعلقة بالعصر العباسي ، حيث عالج قضية القديم والجديد، معتنيا بشعراء المجون. وقد " نبه المازني في كتابه " قبض الريح " إلى أن طه حسين مولع بتعقب الزناة والفساق والفجرة والزنادقة". وأن هذا الكلف بأخبار المجان ستنعكس نتائجه عند تناوله للمتنبي ، وذلك سيتضح في شكه في نسب المتنبي " ، ثم أعقب هذه الأحاديث عن العصر الأموي وعن شعر الغزل والغزليين.
وقد طرح طه حسين في هذه المرحلة مسألة القديم والحديث خاصة بين سنة 1922-1925 حيث كان منشغلا بإبراز صراعه ضد الفكر التقليدي والمحافظ في مصر ، ونضيف أن نزعة الشك لاحت معالمها في الأحاديث قبل أن تتبلور في كتابه " حول الشعر الجاهلي " ، وأكد على ضرورة تمثيل الشاعر لعصره إذ سوف تتطور هذه الفكرة بشكل بارز في كتاباته القادمة حول الشعر الجاهلي وحول المتنبي ، ولقد ساقته فكرة تمثيل الشاعر لعصره وبيئته إلى نتيجة مفادها أن صحة الشعر رهينة بانعكاس البيئة والشخصية فيه، ولقد راح ينقب عن مبررات الشعر الذي شك في وجود أصحابه ، محاولا إبراز الشرط الموضوعي لظهور نوع معين من الشعر، كما فعل مع شعراء الغزل ، حيث شك في وجود أشخاصهم فعوضهم بالنوع الجديد الذي هيمن في العصر الأموي ، إنه فن القصص الغرامي، يقول "لابد للباحث المحقق الذي ينتهي به البحث إلى إنكار قيس بن الملوح والغض من شخصية قيس بن ذريح من أن يقيم مكان هؤلاء الأشخاص أشخاصا آخرين أو أشياء أخرى ، وإلا كان بحثه عقيما ، وكانت نتائجه أثرا من أثر التحكم الذي لا خير فيه وأنا أريد أن أقيم مكان قيس بن الملوح وقيس بن ذريح وجميل بن معمر وعروة بن حزام أشياء لا أشخاص ، أو بعبارة أدق أريد أن أقيم مكانهم شيئا واحدا هو فن القصص الغرامي الذي اعتقد أنه ظهر أو على أقل تقدير قوي وعظم أمره أيام بني أمية."
لقد حاول طه حسين في أحاديثه أن يبحث عن نموذج منهجي متكامل ، ليعيد به قراءة التراث الأدبي، حيث جرب مجموعة مناهج تمنح أدواتها من المنهج التاريخي للأدب، وقد كان فيه سانت بوف وتين وجول لوميتر ولانسون ، وبالرغم من الفروق المنهجية بين هؤلاء النقاد ، فهو يصرح قائلا " وفي الحق إن الناقد لا يقنع بما كان يقنع به سانت بوف أوتين أو جول لومتر أو غيرهم من النقاد ، وإنما يود لو استطاع أن يوفق لهذا كله ويستخلص منه غرضا شاملا يطلبه ويسمو إليه حين ينقد فيفهم شخصية الشاعر أو الكاتب وعصره وفنه " . من خلال هذا التصريح يبدو واضحا أن هم طه حسين هو تأسيس منهج نوفيقي يضم الاختلاف والتعدد الواقع بين هؤلاء النقاد المختلفين في تصوراتهم التي يصدرون عنها. هذه النزعة التوفيقية التي تسعى إلى إدغام المناهج المتعددة والمختلفة في منهج واحد، ستدشن علاقة الناقد العربي بالمنهج، فطه حسين يمثل البدايات الحقيقية لعلاقة الناقد بالمنهج هذه العلاقة يكتنفها الغموض والضبابية. والرغبة الجامحة لدى طه حسين في دعم نقاد عديدين في منهج واحد تبرز بداية الأزمة في العلاقة بالمنهج.
فإذا كان سانت بوف يختلف عن تين وتين يغاير برونـتيير أو لانسون، فإن ذلك مرده إلى أن الرؤية النقدية عندهم مشروطة بالسياق التاريخي الذي تبلورت فيه رؤاهم النقدية ناهيك عن النزعة الحوارية والسجالية بين هؤلاء النقاد. بخلاف طه حسين الذي يتعامل مع تراث نقدي جاهز وسيكون لزاما عليه أن يستفيد من كل إنجازاته ، وهنا تكمن الأزمة في الالتقاء بالمنهج ، فتلقى المنهج جاء من خارج السياق العربي، أي أن تبلور المنهج وقع من خارج صيرورة النقد العربي. بالرغم من أن دواعي التفكير في المنهج أملاه واقع تحجر الدرس الأدبي. وسوف ينسحب هذا اللقاء المازوم مع المنهج على امتداد النقد العربي الحديث أي تبعية العرب للغرب باعتباره منتجا للمعرفة والعرب مستهلكين وفي ابعد تقدير مطبقين.
ويبقى أن نشير أخيرا إلى أن المقولة النقدية التي تبلورت داخل المشروع النقدي لطه حسين بخصوص تمثيل الشاعر لشخصه وعصره ( أي النظرية المرآوية في الأدب ) كانت وراء اختيار الشعراء والكتاب الذين كانوا موضوع الدراسة عند طه حسين. فقد التمس العصر الأموي في شخص عمر بن أبي ربيعة ، وتجسد لديه القرن الثاني أيام هارون الرشيد في شخص أبى نواس ، والقرن الثالث في الجاحظ ، ويبدو أن اختياره للمتنبي لا يند عن هذه القاعدة ، فالمتنبي يمثل القرن الرابع خير تمثيل. أما القرن الخامس فقد مثله شاعر المعرة (المعري) بامتياز.
لقد مثل هؤلاء في نظر طه حسين ألوان الحياة الأدبية لعصورهم واختزلوها في أشعارهم وكتاباتهم، مثلوا نظريته في " مرآوية الأدب " التي ستتحكم في مشروعه النقدي.
| |
|
  | |
الشهبندر
عضو نشيط 
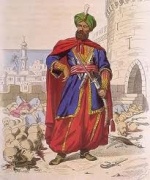
الجنس : 
العمر : 40
 المدينة المنورة المدينة المنورة
التسجيل : 30/09/2011
عدد المساهمات : 141
 |  موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩ موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩  الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:54 pm الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:54 pm | |
|
- اكتمال النموذج المنهجي في كتاب " في الشعر الجاهلي " :
أ- وضعية الكتاب في السياق التاريحي :
تعتبر المحاضرات التي كان يلقيها طه حسين على طلابه في الجامعة في العشرينات بخصوص قراءة الشعر الجاهلي ، التي ستتجمع فيما بعد في كتاب " في الشعر الجاهلي " ، منعطفا في حياة طه حسين الأدبية ، إذ يندرج الكتاب ضمن مشروعه الإصلاحي. وقبل الحديث عن الإشكالية المطروحة في الكتاب ، لابد أن نضع الكتاب في سياقه التاريخي حتى لا نسقط في النقاشات ذات البعد الشجالي التي هيمنت في الفترة التي ظهر فيها الكتاب. إذ أن الشروط الموضوعية المؤسسة لخطاب طه حسين النقدي كفيلة بالإجابة عن التصور التاوي وراء ممارسته النقدية التي اتسمت بنوع من الجرأة لا نظير لها في تاريخنا النقدي.
لقد طرح في عصر طه حسين سؤال إشكالي هو كيف ننهض بدراسة الأدب حتى يرقى إلى المستوى الذي عليه دراسة الأدب عند الغربيين، وأولى الأجوبة التي سيقدمها طه حسين عن هذا السؤال الإشكالي ، هي انتقاده للوضع القائم في تدريس الأدب ، لذلك سيفتتح كتابه بالحديث عن وضعية الأدب في مصر ، وسيوجه انتقاداته لمدرسة القضاء ودار العلماء والثانويات في مصر ، ولمؤسسة الأزهر، حيث رأى أن هذه المؤسسات بعيدة كل البعد عن تدريس الأدب ، وهدف هذا الإصلاح ، أي إصلاح المناهج التي تقارب الأدب، وهدف هذا الإصلاح في نظر طه حسين هو " أن نجتهد ما استطعنا في أن نحبب إلى طلاب المدارس العالية وتلاميذ المدارس الثانوية والابتدائية قراءة النصوص العربية وتفهمها ، ونقرب إليهم هذه النصوص ونحسن لهم الاختيار ، ونظهرهم على أن الأدب العربي ليس - كما يمثله لهم معلموه من الشيوخ - جافا جذبا عسير الهضم لا سبيل إلى إساغته ولا إلى تذوقه وإنما هو عكس هذا كله لين هين خصب لذيذ ، فيه ما يرضي حاجة الشعور، وفيه ما يقوم عوج اللسان ، وفيه ما يصلح من فساد الخلق ، وفيه ما يرضي حاجة الإنسان في حياته الفردية والمنزلية والوطنية والإنسانية ".
من خلال هذا النص يتضح أن الغاية التي من أجلها ينادي طه حسين بالبحث عن منهج جديد لتدريس الأدب هي غاية تعليمية، وقد ارتبطت دعوته هاته بأزمة التعليم، إذ لابد ونحن نتحدث عن المنهج النقدي أن نستحضر هذه اللحظة ، فالهم المنهجي يرتبط أساسا عنده بغاية تعليمية تربوية. وللاضطلاع بهذه المهمة الصعبة لابد وأن تتوفر شروط عديدة في مدرس الآداب وتاريخه، ويمكن إجمال هذه الشروط في أن يتسلح مؤرخ الآداب بمجموعة من المعارف وأن يتفق لغات عددية ، ولأن الأدب متصل بطبيعته اتصالا شديدا بأنحاء الحياة المختلفة سواء منها ما يمس العقل وما يمس الشعور وما يمس حاجاتنا المادية. والأدب بطبيعته شديد الحاجة إلى المقارنات والموازنات " . ودعوة طه حسين إلى موسوعية دارس الأدب ومؤرخه تستند إلى لحظتين ، اللحظة الماضية المتمثلة في الأديب العربي القديم، نموذج الجاحظ مثلا إذ قد كان " الجاحظ أديبا لأنه كان مثقفا قبل أن يكون لغويا أو بيانيا أو كاتبا " .
واللحظة الحاضرة المتمثلة في الغربي الذي يتخذه طه حسين نموذجا ينبغي أن يحتذى، فأستاذ الأدب الفرنسي أو الإنجليزي لا يستحق هذا اللقب " إلا إذا أتقن اليونانية واللاتينية لغة وفقها وأدبا وفلسفة ، ثم أتقن إلى جانب هذا كله لغتين من اللغات الحية على أقل تقدير ، ثم فرغ بعد هذا وبعد ثقافة متقنة ومتينة لناحية يعينها من أنحاء أدبه فأنفق فيها حياته " .
إن النقد الذي يوجهه طه حسين لدارس الأدب في عصره يستحضر نموذجين، نموذج القارئ العربي القديم ، ونموذج القارئ العربي ، هذين النموذجين يضمران تصورا موحدا حول الأدب مما جعل طه حسين يستند لهما، لذلك سيحاول فــي كتابه " في الأدب الجاهلي " أن يحدد المراد بكلمة أدب هذه الكلمة المستعصية على التحديد وسيستند في تحديدها إلى قراءة النصوص التي استعملت أول ما استعملت في الدلالة على التعليم. أي التعليم المألوف في هذا العصر الذي يعتمد " طريقة الرواية على اختلاف أنواعها رواية الشعر ، ورواية الأخبار ، وأحاديث الأولين ، وكل ما يتصل بالعصر الجاهلي وسيرة الأبطال قدمائهم ومحدثيهم ، وكل ما كان من شأنه تكوين الثقافة التي كان يحرص عليها العربي المستتير من الأرستقراطية الحاكمة ".
إن غايته من تحديد كلمة الأدب بهذه الطريقة سيخدم تصوره حول دراسة الأدب بعيدا عن كل نزعة دينية، إذ كلمة الأدب " كانت تدل منذ العصر الأموي على هذا النحو من العلم الذي ليس دينا ولا متصلا بالدين، وإنما هو شعر وخبر أو متصل بالشعر والخبر " . إن هذا المفهوم للأدب سيستغله طه حسين في مناقشته للشعر الجاهلي بعيدا عن كل تعصب ديني ، وطه حسين يحاول تجريد الأدب من كل تقيس، ويركز اهتمامه على دراسة النص الأدبي لذاته مثلما تفعل العلوم الأخرى، ويظهر تأثير " ديكارت هنا جليا، إذ يعمد طه حسين إلى القاعدة الأساسية في المنهج الديكارتي و " هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعمله من قبل، وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه خلوا تاما ". لذا يؤكد طه حسين على أهمية استقلال تاريخ الأدب عن كل عاطفة قومية أو دينية، وأن ندعي لمناهج البحث العلمي الصحيح.
إن ما يقابل هذا التصور لقراءة الأدب على الصعيد الأيدلوجي، هو المفهوم الذي أعطاه طه حسين للفكرة القومية المصرية، والتي عرفت صراعا هاما في اللحظة التي كان يكتب فيها كتاباته حول النص الأدبي العربي القديم خلال العشرينات مفهوم للقومية المصرية يلغي الجانب الديني ولا يعتمد إلا الجانب الاقتصادي، وهي نفس النظرة التي تبناها أستاذه أحمد لطفي السيد، وأصحاب النظرة الليبرالية التي تسعى إلى أبعاد التعصب الديني عن النظرة القومية ".
وبالإضافة إلى مفهومه للقومية البعيد عن كل تصور ديني، فإنه يركز على مبدأ الحرية واستقلالية الأدب، وهذه الدعوة للحرية ترتبط بتوجهه الليبرالي، فالأدب ينبغي أن يتحرر، وأن يستقل بموضوعه، إذ أن ارتباط الأدب بقضايا خارج المجال الأدبي، يقف سدا أمام مساءلته والشك فيه، لذا يرى أن تحرير اللغة والأدب ودرسه مستقلا يساهم في تطويره، فالأدب ينبغي أن يدرس كغاية في ذاته وليس وسيلة، إذ ما دام يدرس كوسيلة لفهم النص القرآني، فإننا سنضفي عليه صبغة القدسية مما يحول بيننا وبين الشك فيه، وبحثه علميا دقيقا، وإذا ما تمت دراسته في معزل عن تقديسه فإن " الحرية بهذا المعنى شرط أساسي لنشأة التاريخ الأدبي في لـغـتـنـا العربية ". ويريد طه حسين أن يدرس " تاريخ الآداب في حرية وشرف كما يدرس صاحب العلم الطبيعي علم الحيوان والنبات لا يخشى في هذا الدرس أي سلطان ".
والمطالبة بحرية درس الأدب يوجهها لدى طه حسين أكثر من سبب، يأتي الإصلاح على رأسها، بالإضافة إلى اعتبار الأدب يخدم المجتمع كباقي المجالات الأخرى، ناهيك على أن الحرية توفر للدارس أن يعيد قراءة التراث الأدبي قراءة مغايرة، وإذا انتقى هذا الشرط فإن القراءة ستعيد إنتاج ما قاله القدماء، وفي نظر طه حسين لا حاجة بنا لأن نعيد ما قاله القدماء ".
إن نموذج طه حسين في هذا التصور للأدب هو الغرب الليبرالي، الذي استطاع أن يتخلى عن أفكار القرون الوسطى ؛ بثورته على الكنيسة واستخدام العقل في الـنبش على الحقيقة اليقينية، بالإضافة إلى سيادة سلطة العلم التجريبي بدل الخرافات والفكر اللاهوتي، إن الغرب تقدم من مجال العلوم لما صفى حسابه مع الكنيسة التي كانت تضفي القدسية على الأشياء، وقد تطور الدرس الأدبي لأن الأدب استقل بموضوعه كبقية العلوم الأخرى. لذا كان لزاما لكي يتقدم المجتمع العربي - في نظر طه حسين- أن يتخلص من سلطة الأزهر وغيرها من السلط التقليدية (ملحوظة : ألف طه حسين كتابه بعد عودته من فرنسا حين تشبع بالفكر الليبرالي).
| |
|
  | |
الشهبندر
عضو نشيط 
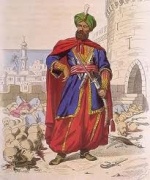
الجنس : 
العمر : 40
 المدينة المنورة المدينة المنورة
التسجيل : 30/09/2011
عدد المساهمات : 141
 |  موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩ موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩  الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:55 pm الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:55 pm | |
|
ب : إشكالية التاريخ الأدبي عند طه حسين :
إذا كان الأدب في نظر طه حسين مستقلا بموضوعه، فإن تاريخ الأدب لا يمكنه أن يستقل عن مجموعة من المعارف والعلوم التي تمده بالأدوات والوسائل الإجرائية، أما الدعوة إلى علمنة تاريخ الأدب، فإنها ليست خالصة لأن تاريخ الأدب لا يستطيع أن يعتمد على مناهج البحث العلمي الخالص وحدها، وإنما هو مضطر معها إلى الذوق، هو مضطر معها إلى هذه الملكات الشخصية الفردية التي يجتهد العالم في أن يتحلل منها ".
إن طه حسين يدرك الفروق بين طريقة البحث في العلوم الحقة والعلوم الإنسانية، إذ العلاقة بين الذات والمـوضـوع في المعرفة الخالصـة هي علاقة تباعد، أما في البـحـث الأدبي فإن العلاقة تأثرية، " فتاريخ الأدب علم من جهة، ولكنه لا يستطيع أن يكون علما كالعلوم الطبيعية والرياضية، لأنه متأثر بهذه الشخصية، ولأنه لا يستطيع أن يكون بحثا "موضوعيا"، وإنما هو بحث ذاتي من وجوه كثيرة، ففيه موضوعية العلم وذاته الأدب ".
إن مرد هذا الفهم لتاريخ الأدب، هو تصور طه حسين لموضوع تاريخ الأدب، حيث أن هذا الأخير يعنى بدراسة جملة النصوص الأدبية المأثورة، ولكنه لا يكتفي بذلك، حيث أنه يتناول أشياء أخرى لا سبيل إلى فهم النصوص الأدبية وتذوقها إلا إذا فهمت، وعرف تأثيرها فيها وتأثرها بها " : فمؤرخ الأدب يتحلى بالروح العلمية عندما يبحث من مختلف العوامل التي أثرت في إنتاج النصوص الأدبية، أما عندما يريد الحكم على جمالية النص فإنه يعتمد على ملكة الذوق، ويمكننا أن نرى من هذا التصور لتاريخ الأدب تأثير " غوستاف لانسون " على طه حسين حيث أن هذا الأخير تعلم من لانسون " أن العمل الأدبي يختلف عن الوثيقة التاريخية بما تثيره صياغته من استجابة عاطفية وجمالته، كما تعلم منه أن على الناقد أن يتوقف إزاء هذه الصياغة معتمدا على ذوقه التاريخي، فليس هناك مبادئ صارمة لدراسة كل عمل أدبي، فالمهم هو التوقف عند صياغة هذا العمل، والاستجابة إلى الهزة التي تحدثها في الناقد، والكشف من خلال هذه الهزة عن منحى خاص في الصياغة، ثم ربط هذا المنحى بروح الكاتب أو حياة الأفراد، وبذلك يصبح النقد عملية تذوق لكل كاتب بنسبة ما في أسلوبه من كمال .
إن هذا الدرس اللانسوني، دفع طه حسين إلى انتقاد كل من سانت بوف وتين وبرونتير، من زاوية أن كلامهم ركز على جانب من جوانب الظاهرة الأدبية وأغفلا جوانب أخرى، وقد كانوا يهدفون إلى إثبات إمكانية دراسة الأدب بطريقة موضوعية، في حين أن هذا المنزع العلمي لا يمكنه التحقق، لأن النقد الأدبي لا يمكن أن يصبح علما، أو أن يحاكي أي علم من العلوم، وإنما عليه أن يستقل بمنهجه، ويربط بين طبيعته الخاصة وطبعة الأدب الذي يدرسه، لذلك فطبيعة تاريخ الأدب عند طه حسين هي عمل أدبي في حد ذاته، إذ أنه سيستحيل " أن يؤرخ الآداب غير الأديب" لما بينهما من صلات ووشائح تمنع من أن يقوم التاريخ الأدبي علما مستقلا بذاته.
إذن، فتاريخ الأدب عند طه حسين يتناول النصوص الأدبية، فيؤرخ لها، ولكنه " يوسع ميدان بحثه، ويتناول أشياء قد لا يستطيع أن يتناولها من يعنى بالأدب، من ذلك أنه يدرس تاريخ السياسة والاقتصاد، ولكنه يدرسها من حيث هي مكملة لبحثه " فلفهم خمرية من خمريات أبي نواس يضطر مؤرخ الأدب إلى أن يدرس التوحيد واختلاف أهل السنة والمعتزلة ، ناهيك على أنه يبحث أيضا في نشأة الأدب وفي تاريخ ظهور أغراضه وفنونه واتجاهاته ومدارسه، ويؤرخ للنصوص وللأعلام الذين أنتجوها، ويحاول الوقوف على حركة سير الاتجاهات الأدبية.
من خلال تتبعا لإشكالية التاريخ الأدبي عند طه حسين، تبين أن تصوره يندرج ضمن مشروعه الإصلاحي، فهو يؤكد أنه لا يريد أن يستحدث منهجا للتاريخ الأدبي لم يعرفه العرب ، وإنما يهدف إلى تطوير وسائل البحث في الأدب تراعي خصوصية اللحظة الزمنية التي يعيشها، فالممارسات النقدية للجاحظ والمبرد. وابن قتيبة وابن سلام تعتبر في نظره أدبا وصفيا، حاول من خلاله هؤلاء النقاد أن يصفوا أدبهم ويرتبوه ويستنبطون من الأصول والنظريات، غير أن ما كان يحملهم في وصفهم للأدب ظروفهم الموضوعية، وتاريخ الأدب كائن حي يتطور بتطور المكان والزمان ؛ " فكما أن التاريخ لا يوصف بصفة محددة كذلك، فإن التاريخ الأدبي يتجدد بلا انقطاع لأن حوادث جديدة تكتشف دائما، كما أن تفسير هذه الحوادث واستخدامها لا يعني يقينا مطلقا، وأن الفن لا يقتضي الدقة والصحة وحسب، وإنما يلزمه أيضا نوعا من العبقرية "، لذلك فعملية التاريخ الأدبي عند طه حسين لا تمثل قطيعة مع ما بدأه القدماء، وإنما هي استمرار وتطوير للأداة الإجرائية يقول طه حسين بهذا الصدد "فتاريخ الأدب الذي نريد أن نستحدثه الآن ليس إنشاء ولا اختراعا، وإنما هو تجديد و إصلاح لما تركه القدماء لا أكثر ولا أقل، فعلى أي قاعدة وعلى أي منهج نريد أن نأخذ في هذا التجديد والإصلاح".
ولتنفيذ هذا المشروع لابد من اعتماد مقياس معين، هذا المقياس سيتبلور بعد عملية نقدية للمقاييس التي اعتمدها مؤرخون آخرون، وأبرز المقاييس التي اعتمدت في التاريخ الأدبي هو المقياس السياسي، خاصة في النظرية المدرسية، التي يمثلها كل من حسن توفيق العدل، وأحمد الإسكندري وأحمد حسين الزيات، وفي هذه النظرية يتم ربط الأدب بالسياسة ربطا ميكانيكيا يعطينا تحقيقا للأدب حسب العصور السياسية.
وطه حسين يرفض أن يقسم الأدب إلى عصور سياسية، وأن نربط الأدب بالازدهار السياسي إذ قد " يكون الانحطاط السياسي مصدر الرقي الأدبي أيضا، والقرن الرابع الهجري دليل واضح على أن الصلة بين الأدب والسياسة قد تكون صلة عكسية في كثير من الأحيان "، فالحياة السياسية لا تصلح أن تكون مقياسا للحياة الأدبية، وإنما هي مؤثر من المؤثرات، فينبغي أن يتأسس تاريخ الأدب داخل الأدب " من حيث هو ظاهرة مستقلة يمكن أن تؤخذ من حيث هي وتحدد لها عصورها الأدبية الخالصة". وبالإضافة إلى نقده النظرية المدرسية، فإنه ينتقد أصحاب المقياس العلمي في التاريخ الأدبي وقد رأيناه آنفا ينتقد كلا من سانت بوف وتين اللذين حاولا أن يقيما تاريخا أدبيا يستلهم النماذج العلمية، فالمقياس العلمي في نظره يعجز عن تفسير النبوغ، و " مادام التاريخ الأدبي لا يستطيع أن يفسر لنا بطريقة علمية صحيحة نفسية المنتج والصلة بينها وبين ما تنتج، ومادام التاريخ الأدبي لا يستطيع أن يبرأ من شخصية الكاتب وذوقه، فلن يستطيع أن يكون علما، والحق أني لا أفهم لم يحرص على أن يكون علما ".
بعد عدوله عن المقياس السياسي والعلمي سيتبنى مقياسا أدبيا، وقد تجلى ذلك في تنبيه لنظرية المذاهب الفنية، وقد عرض نظريته بشكل تطبيقي عند دراسته لمدرسة زهير، حيث عرض في كتابه " في الأدب الجاهلي إلى مدرسة زهير الفنية وأبان عن خصائص هذه المدرسة وما تمتاز به، وكشف عن طريقتها من تناول الأشياء وعرضها، ووضع يده على طائفة كبرى من هذه المميزات التي شارك فيها زهير أوس بن حجر من قبله والحطيئة وكعب بن زهير من بعده وجميل بعد الحطيئة، ووجد في هذه السلسلة مذهبا فنيا متكاملا يأخذ به جيل بعد جيل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصور لمذاهب الفنية يعتبره طه حسين امتدادا لما سجله النقاد القدامى من ملاحظات حول العلاقات الفنية التي تجمع بين مجموعة من الشعراء، فطه ينفي أن يكون قد استنبط هذا المذهب من عنده، وإنما هو شيء تحدث به الأقدمون حين أشاروا أن زهيرا كان راوية أوس وأن الحطيئة كان راوية زهير.
وتتجلى قيمة هذه النظرية في التاريخ الأدبي في أنها تقلب وجه الدراسة الأدبية وتغير معالمها " ذلك أنها إنما تنشد التقاء الخصائص الفنية في جماعة من الأدباء أو جماعة من الشعراء نزعوا عن رغبات متقاربة ونهجوا مسالك متوازية واستطاعوا في نتاجهم الأدبي أن يكون لهم من السمات ما يوحد بينهم ... وأنها ستحل الوحدة الفنية محل الوحدة الزمنية.. وأن هذه الوحدات الفنية ستكون مجالا واسعا للجهد والخضب وللعمل المنتج ولهذا التجديد في تناول الأدب العربي وعرضه وفي تجديد صورته تجديدا لا يقوم على أساس خارجي من السياسة مثلا أو من التاريخ.. وإنما على أساس داخلي هو الإحساس العميق بما توفر لهذه الوحدة الفنية من جهد وما انطوت عليه من إبداع ".
غير أننا ينبغي أن ننبه إلى أن هذه النظرية بقيت محكومة بالتصور العام للتأريخ الأدبي عند طه حسين، فقد اقتصرت على تناول القمم الشامخة في الأدب، ولا جرم أن هذا التصور في التأريخ يرجع إلى المفاهيم التي يحملها طه حسين حول الأدب ووظيفة الأدب، لأن " الطريقة التي نتناول بها النصوص القديمة ترتكز على نمط وعلى تعريفات تختلف درجة وضوحها بحسب الباحثين، وعندما يتعلق الآمر بنصوص أدبية، فإن الباحث يعتمد طيلة عمله، سواء شاء ذلك أم كره على تعريف للأدب وعلى مفاهيم تعيب أحيانا عن وعيه ".
ويبدو أن مفهوم التعبير هو النواة المحركة لتصور تاريخ الأدب عند طه حسين، هذا المفهوم يلزم المؤلف الكلاسيكي أن يكون مرآة لعصره، وعندما لا يتيسر المرور من النص إلى المجتمع أو المؤلف، فإن الباحث يلوم المؤلف ويؤنبه، أو قد يشك في كينونته كما حصل ذلك مع الشعراء الجاهلين وشعراء الغزل العذري عند طه حسين.
ومرد ذلك أن تاريخ الأدب عند طه حسين لا يعنى بالأنواع الأدبية وبمنطقها الداخلي ، ناهيك على أن مفهوم النص الأدبي لم يكن بالدقة المطلوبة لديه، فتاريخ الأدب لابد وأن يحدد مجموعة من المفاهيم تخص المؤلف، و النص، و الأدب. إن تصوراتنا حول هذه المصطلحات هو الذي يبلور لدينا تأريخا للأدب بطريقة سليمة.
فالغائب عن التأريخ الأدبي عند طه حسين هو أن النص الأدبي " لا يعرف الاستقرار والجمود، ذلك أنه يخضع لمنطق خاص هو " منطق السؤال والجواب "، النص يجيب عن سؤال يضعه المخاطب، وبتعدد المخاطبين والأزمنة تتعدد الأسئلة والأجوبة... وبالمقابل فإن النص بدوره يطرح أسئلة وعلى المتلقي هذه المرة أن يجيب ".
إن إهمال هذا التصور للنص الأدبي يقود إلى تأريخ ناقص، حيث أن التأريخ الأدبي يسعى إلى تأريخ للقراءة التي مورست على النص عبر العصور، ورصد أنواع الاستجابات لدى القراء المتنوعين والمختلفين عبر الأزمنة، فإذا كان تاريخ الأدب هو تأريخ نشأة النصوص الأدبية ومنتجيها، فإنه لا محالة سيغفل جوانب أساسية في بلورة تاريخ أدبي دقيق ومن أبرز هذه الجوانب المغفلة لدى طه حسين أو غيره من المؤرخين الذين عاصروه هو إهمال ظروف إنتاج النصوص الأدبية وطرق نشرها وإذاعتها في الناس، وإهمال للمقاييس التي تختار بها النصوص وتتوج أدبا. " إذ التأريخ للنصوص الأدبية وحدها والرجال الذين أبدعوها فحسب يؤول إلى عناية بسيطة بنشأتهما وبظهور أصحابها وبانضمام بعضهم إلى بعض على خط الزمن، وهي عناية تفتقر إلى البحث عن عمل الظاهرة الأدبية واستعمالها في المجتمع، وتفتقر بالتالي إلى تحليل ظروف نشأة النصوص وطرق حياتها ومكانتها بين المعارف وعلاقتها بالنظام الاجتماعي والاقتصادي التي تظهر فيه ".
بعد مناقشتها لمفهوم تاريخ الأدب عند طه حسين، سننتقل في الشطر الثاني من الفصل إلى بحث تجليات هذا المنهج في الدراسة المخصصة للمتنبي.
| |
|
  | |
الشهبندر
عضو نشيط 
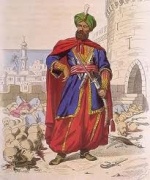
الجنس : 
العمر : 40
 المدينة المنورة المدينة المنورة
التسجيل : 30/09/2011
عدد المساهمات : 141
 |  موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩ موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩  الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:56 pm الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:56 pm | |
|
السياق التاريخي لكتاب " مع المتنبي "
بعد أن عرضنا في الفصل السابق، العناصر المكونة للمشروع النقدي عند طه حسين سنحاول الآن وضع كتاب " مع المتنبي " في سياق هذا المشروع، مبرزين المكانة التي يحتلها الكتاب ضمن التصور العام لطه حسين ، فهل هذا الكتاب يشكل امتدادا للمشروع ؟ أم ارتدادا ؟ وما المنهج الذي اتبعه ليقرأ به المتنبي قراءة جديدة تخالف القراءات السابقة ؟ وما هي الخلفيات الثقافية والسياسية والاجتماعية والجمالية المتحكمة في طبيعة تلقي نص المتنبي من طرف طه حسين ؟
إن هذه الأسئلة تسعى إلى مساءلة القراءة النقدية التي مارسها طه حسين على شخصية المتنبي وشعره،وإن أول خطوة في الإجابة عن هذه الأسئلة هي وضع الكتاب في الإطار التاريخي الذي ورد فيه.
ألف طه حسين كتابه " مع المتنبي " في صيف 1936 بفرنسا ، وقد كان من وراء تأليفه له دوافع صرح بها في بداية الكتاب مستبعدا كل الدوافع الذاتية ؛ يصرح في البداية أن المتنبي ليس شاعره الأثير، يقول بهذا الصدد : " وليس المتنبي مع هذا من أحب الشعراء إلي وآثرهم عندي ولعله بعيد كل البعد أن يبلغ من نفسي منزلة الحب أو الإيثار. ولقد أتى علي حين من الدهر لم يكن يخطر أنى سأعتني بالمتنبي وأطيل صحبته أو أديم التفكير فيه " .
فإذا ما استبعدنا الدافع الذاتي ، فما هو الدافع الحقيقي وراء هذه الصحبة المضنية والمكلفة، إن الإجابة عن هذا السؤال تتحدد من خلال اللحظة التاريخية التي ألف فيها الكتاب، ذلك أنه منذ العشرينات والثلاثينات من هذا القرن كان المتنبي هو الشاعر المفضل لدى الدارسين ، وقد كان هذا الاهتمام البالغ حافزا أساسيا عند طه حسين لكي يخصص كتابا مستقلا حول المتنبي، إذ كانت تحدوه رغبة لكي يجيب عن سر هذا الاهتمام " فالمتنبي كان ومازال حديث الناس المتصل منذ أكثر من عامين، ولأني حاولت ومازلت أحاول أن أستكشف السر في حب المحدثين له وإقبالهم عليه وإسرافهم في هذا الحب والإقبال، كما أسرف القدماء في العناية به حبا وبغضا وإقبالا وإعراضا " .
إن هذا التساؤل حول سر الاهتمام بالمتنبي هام جدا لأنه يضعنا أمام إشكالية كبرى في تاريخ النقد الأدبي الحديث، أي البحث في العلاقة بين الأدب والجمهور. هذه العلاقة التي ظلت مغيبة في النقد إلى حدود القرن العشرين، فهل استطاع طه حسين أن يقرأ المتنبي من خلال مجموع القراءات التي أنجزت حوله ؟ هذا ما لم يتم القيام به، فطه حسين لم يبحث في العلاقة بين شعر المتنبي والجمهور المتلقي، فبالرغم من تساؤله حول العناية الفائقة بالمتنبي، واستمرارية الدراسات حوله، لم يسلك الطريقة المفضية لملامسة سؤال الاستمرارية، فبدل أن يرصد تمثلات القراء الواقعيين أو المفترضين، حول شعر المتنبي، راح يؤسس سيرة للشاعر من خلال شعره، وليس في ذلك غرابة لأن المنهج الدراسي الذي كان سائدا في مرحلته منهج يعني بالشخصية وأثر الواقع فيها، وهو منهج بعيد كل البعد عن إشكالية الأدب والجمهور.
إضافة إلى أن المرحلة التاريخية التي ألف فيها الكتاب اتسمت من الناحية السياسية ببروز الوعي القومي، خاصة وأن العالم العربي عرف في هذه اللحظة حركات تحررية ضد الاستعمار ودخل في مرحلة البحث عن الذات في مواجهة الآخر. وقد كان هذا الوعي والحس القومي العروبي من وراء اهتمام الدارسين العرب بالمتنبي إذ وجدوا فيه الصوت المعبر عن رغبتهم في التحرر، وهذا ما يفسر تلك المهرجانات الألفية التي أقيمت في جل العواصم العربية احتفاء بشاعر العروبة.
في خضم هذا التراكم من الدراسات سيكتب طه حسين كتابه حول المتنبي، وسيكون ملزما بإقامة حوار مع هذه الدراسات، خاصة وأن ثلاثة كتب أساسية حول المتنبي كتبت قبل كتابه الأول للمستشرق الفرنسي رجيس بلاشير سنة 1935 وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه. لقد كانت هذه الجودة غاية في الجودة وفي حذق المنهج التاريخي.
فقد جمع ما جاء شتاتا في تضاعيف المصنفات والمخطوطات من أسماء الذين اهتموا بأبي الطيب وشعره من القدماء والمحدثين، ووصف أعمالهم وأصدر فيها أحكاما صائبة فتحت الطريق للذين جاءوا بعده. أما الثاني، فهو كتاب محمد محمود شاكر الذي انتهج فيه صاحبه منهجا سماه منهج الذوق *، بحيث التزم في كتابه الدقة في التوثيق، وتوصل إلى مجموعة من النتائج، كإبطال القول بقرمطية المتنبي، وإلحاق المتنبي بنسبه العلوي، وإبطال إدعاء النبوة. والكتاب الثالث هو لعبد الوهاب عزام. وقد اتسم هذا الكتاب بالتوثيق التاريخي لمراحل حياة المتنبي.
فبالرغم من أن طه حسين صرح في مقدمة كتابه بأن طلب من صاحبه أن يأخذ نسخة من ديوان المتنبي ويترك كل ما كتب حوله ، فإن طه حسين كان يستحضر النتائج التي توصل إليها سابقوه وإلا فبماذا نفسر الإحلات الموجودة في الكتاب عن بلاشير ومحمود شاكر ، وعبد الوهاب عزام.
إن النتائج التي توصل إليها طه حسين تتحدد من خلال النتائج التي سبق إليها فهو إما أن يكون مرددا لما سبق أو أن يكون مخالفا له. إنه يقيم جدالا وسجالا خفيا مع محمود شاكر ومع بلاشير.
| |
|
  | |
الشهبندر
عضو نشيط 
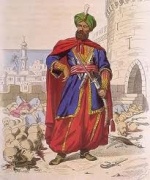
الجنس : 
العمر : 40
 المدينة المنورة المدينة المنورة
التسجيل : 30/09/2011
عدد المساهمات : 141
 |  موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩ موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩  الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:57 pm الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:57 pm | |
|
المفاهيم المحددة للعملية التأريخية
إن معالم المنهج التاريخي تبدو جلية في الدراسة التي قام بها طه حسين حول المتنبي، ذلك أنه تتبع حياة الشاعر منذ صباه إلى وفاته مسترشدا بما جاء في الديوان من إشارات تاريخية، وكان يرغب من وراء هذه العملية أن يعيد تشكيل حياة الشاعر كما ظهرت من خلال ديوانه، فما هي إذن المفاهيم التي توسلها للقيام بهذه العملية التاريخية ؟
لقد تداخلت عدة مفاهيم ضمن دراسته لتنهض بإعادة تشكيل تاريخ المتنبي الشعري والحياتي. وأولى المفاهيم المعتمدة لدى طه حسين هي أن إعادة كتابة التاريخ لا تعتمد على المرويات والاخبار المتداولة حول حياة الشاعر في القديم، لذلك اكتفى بالنص كمعيار أساسي في التأريخ.
1- النص يؤرخ لصاحبه :
انطلاقا من المفهوم الوضعي الذي يعتبر النص وثيقة، سيعيد طه حسين كتابة تاريخ المتنبي، إذ تتبع حياته من خلال استقرائه لأشعاره، باحثا عن الاشارات التي من شأنها مساعدته في تركيب حياته وترتيب تطورها، من هذا المنطلق " تستطيع أن تقول في البداية إن طه حسين كان يهدف إلى تقديم نموذج من القراءة نستطيع بها صياغة التاريخ الادبي معتمدين في ذلك على النص الثابت الصحيح الذي يستطيع وحده أن يقوم بناء تاريخيا صحيحا في إمكانه أن يلغي جميع التأويلات التي لا تثبتها النصوص وألا يقبل من إخبار الرواة المؤرخين إلا ما يوافقها ".
ولنتساءل بهذا الصدد هل كان بإمكان طه حسين أن يقوم على هذا المنهج في التأريخ لو لم يجد أمامه قصائد المتنبي مرتبة ترتيبا تاريخيا 1، خاصة عند شارح الديوان " الواحدي "، وعند كل من بلاشير وعبد الوهاب عزام ومحمد محمود شاكر.
قد نذهب إلى القول بأن هذا الترتيب التاريخي للديوان كان من بين الأسباب التي حفزت طه حسين إلى اختيار المتنبي كموضوع لدراسته التاريخية، فقد دعا منذ زمن مبكر إلى أن التاريخ الادبي ينبغي أن يصدر عن النصوص الموثوقة، والمؤرخة لذلك فقد شك في صحة الشعر الجاهلي لأنه لا يوصل إلى تصوير الحياة الجاهلية، من هذا المنطلق يرى أن قيمة النص تكمن في مدى تمثيله لروح العصر والشخصية التي صدر عنها.
إن الترتيب التاريخي للنصوص يعتبر لديه الطريقة المعقولة في دراسة الأدب لأنه يساعد على رصد تطور الشاعرية عند الشاعر، يعبر عن ذلك وهو بصدد حديثه عن الأخطل : " إن الطريقة المعقولة في دراسة فن الأخطل تقتضي أن نرتب شعره ترتيبا تاريخيا مراعين أطواره التي مربها في أسنانه المختلفة... بمعنى أن ندرس شعر الأخطل في شبابه ثم نتابع دراسته بعد أن تقدمت به السن ثم نواصل هذه الدراسة بعد أن تم له النضج الفني "
غير أن إشكالية التاريخ للشاعر من خلال نصوصه الشعرية تطرح مجموعة من المآزق ، بحيث يغلب على هذه العملية سلطة الظن والاحتمال ، ولنذكر على سبيل المثال لا الحصر مسالة تضاربت حولها تفسيرات النقاد المحدثين ، تتعلق بنسب المتنبي ، فقد حاول طه حسين أن يلتمس لهذا المشكل جوابا من خلال النص الشعري.
وكما هو معلوم فإن مسألة نسب المتنبي أثير حولها نقاش كبير عند القدماء والمحدثين ن إذ كان خصوم المتنبي يغمزونه من نسبه محاولين الحط من كبريائه فهم يذكرونه بأن أباه كان سقاء يسقي لأهل محلته، بالإضافة إلى اختلاف الروايات في اسم أبيه ، ومن الدارسين المحدثين - كمحمد محمود شاكر وعبد الغني الملاح وعصام السيوفي من ارجع اصول المتنبي إلى الشيعة العلويين وراحوا يفسرون شعره انطلاقا من هذا النسب ، يفسرون أخفاء نسبه إلى مسألة التقية التي كان يتخذها الشيعة كوسيلة لعدم التعرض إلى بطش العداء .
أما طه حسين فقد انصرف عن جميع الأخبار المروية في كتب الادب، محاولا تحقيق هذه المسألة من خلال الشعر، فكيف استنطق قصائد الشاعر لتبوح له بنسبة المغمور ؟
لقد انطلق طه حسين من شعر المتنبي ليثبت أن هذا الأخير لم يكن يعرف أباه، إذ تساءل " أكان المتنبي يعرف أباه ؟ قال المؤرخون نعم، ولم يقل المتنبي شيئا، فأنت تقرأ ديوانه من أوله إلى آخره وتقرؤه مستأنيا متمهلا، فلا تجد فيه ذكرا لهذا الرجل الطيب الذي أنجب للقرن الرابع شاعره العظيم ".
بالاضافة إلى أن الشاعر لا يعرف أباه فإنه أيضا لا يعرف أمه إذ لم يرد ذكرها في الديوان، فقط ذكر جدته ورثاها.
نلاحظ أن طه حسين أثار هذه القضية، وجادل فيها غير أنه لم يشف المسألة درسا وبحثا وإنما خلص إلى نتائج ظنية، فأسلوبه في عرض هذه القضية " الثانوية " اسم بالمراوغة والضبابية، تجلى ذلك عندما أنهى حديثه عن هذه القضية بقوله " فنحن لا نسر، أو أنا على أقل تقدير لا أسر ولا آحزن إن ظهر أن نسب المتنبي، من جهة أبيه أو من جهة أمه، قد كان صريحا أو مدخولا، ونحن نبحث، أو أنا على أقل تقدير أبحث من أمر المتنبي على شيء أبقى وأرقى، وأقوم من نسبه العربي الصريح أو المدخول، عن أدبه وفنه، ومكانته من الادباء، وأصحاب الفن القدماء والمحدثين " ، لكن إذا كان هم طه حسين هو البحث عن فن المتنبي، لفم فصل القول في مسألة نسب الشاعر، وخلص إلى الشك فيه، حيث رماه بالسفاحية، وقد استغرق الحديث عن ذلك أربعة فصول من كتابه، جد في أن يسرد ماظنه مظاهر غموض أحاطت بحياة الشاعر، وانتهى إلى الاقتناع بأن " مولد المتنبي كان شاذا، وبأن المتنبي أدرك هذا الشذوذ وتأثر به في سيرته كلها " ، وإذا كان طه حسين يلمح من كتابه لهذا النسب الشاذ، فإن أحد تلامذته تؤكد بأنه بعد مضي سنوات عن تأليفه للكتاب " لا يغير من رأيه ولا يخفف من هجمته، وإنما ينتقل من التلميح إلى التصريح، ويمضي ويكررفي محاضراته أن المتنبي ابن سفاح مقررا فيما يشبه الزهو بأنه أول من اكتشفت هذا الأمر ".
إن الذين أرخوا للمتنبي قديما وحديثا لم يتوصلوا إلى هذا الاستنتاج الذي يسيءلشاعر كبير كأبي الطيب.
بعد هذا الاستنتاج انتقل طه حسين إلى مناقشة مسالة عروبة المتنبي، وانتهى إلى أنه لا يكاد يشك في " أن المتنبي قد كان عربيا، ولكن بشرط أن نفهم من لفظ العربي معنى أو سع وأعمق وأصدق مما كان يفهمه النسابون من العصور الأولى، ومما يفهمه المقلدون من الادباء من العصر الحديث، فأين العقل العاقل الذي يستطيع أن يصدق مما كان يقال من العصور الأولى وما لايزال يقال في كثير من المدارس الادبية، من أن العربي الصريح أو العربي الصليبة هو الذي يعرف له نسب صحيح إلى قبيلة من قبائل العرب في الشمال أو في الجنوب... إنما حفظ الأسباب مزية قد اختصت بها طبقات من إشراف العرب وساداتهم في بعض الأوقات ثم أصبحت سنة موروثة وعادة مألوفة ومظهرا من مظاهر الارستقراطية ".
إن طرحه لهذه القضية موجه بدون شك لبعض القدماء والمحدثين فهو يتغيا تجاوز هذا الثابت في القراءة الكلاسيكية مؤسسا قراءته على نظرة عالمية شمولية لا تطمح إلى إلغاء الفواصل والحدود التي يمكنها أن تغض من شعر الشاعر، ليفتح أمام القارئ العربي إمكانية إعادة قراءة النص العربي متحررا من هذه الاعتبارات الموروثة من القراءة العربية القديمة.. كما أنه بإمكان هذه النظرة أن تجعل القارئ العربي يعيد النظر في بعض الشعراء الذين ظلمهم التاريخ الادبي لاعتبارات كان بعضها يتعلق بنسبهم أو انتماءاتهم إلى أصول غير عربية ".
ويمكن ربط هذا التصور بمفهومه الليبرالي للقومية التي لا تنهض على أساس اللغة والدين والجنس، وإنما تقوم على المنافع الاقتصادية فقومية المتنبي في نظر طه حسين كان لها " أبلغ المؤثرات في حياته العملية... والفنية على كل حال، وقد أنبأنا المتنبي برأيه هذا في نفسه حين قال :
لا بقومي شرفت بل شـرفـوا بـي
وبـنـفسي فـخرت لا بجدودي (الخفيف)
وبهم فخر كل من نطق الـضـــا
د وعون الجاني وغوث الطريد "
إن قومية المتنبي لا تستمد من الارث الماضوي، وإنما هي قومية يكون فيها الفرد هو سيد مشروعه، ومن هنا لابد أن نلمح إلى أن استدلال طه حسين بهذين البيتين يؤكد تصوره الليبرالي للقومية، الممجدة للذات وللمنافع الاقتصادية، والمغيبة للجنس والدين واللغة.
| |
|
  | |
الشهبندر
عضو نشيط 
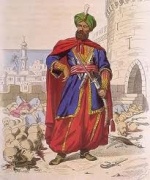
الجنس : 
العمر : 40
 المدينة المنورة المدينة المنورة
التسجيل : 30/09/2011
عدد المساهمات : 141
 |  موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩ موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩  الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:58 pm الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:58 pm | |
|
- الطفولة محددة للشخصية :
لقد انطلق طه حسين في العملية التاريخية من نقطة البداية، من طفولة المتنبي، واعتبر هذه اللحظة مسؤولة على تكوين شخصية المتنبي مطبقا نظرته في الجبر النفسي والتاريخي، فشعور المتنبي " بهذه الصفة أو بهذا الضعف من ناحية أسرته وأهله الأدنين قد كان العنصر الأول الذي أثر في شخصيته، وبغض إليه الناس، وفرض عليه أن يرى أن حياته بينهم لم تكن كحياة أترابه ورفاقه، وإنما كانت حياة يحيط بها كثير من الغموض ويأخذها كثير من الشذوذ "، ويشير طه حسين إلى أن هناك عناصر أخرى كونت شخصية المتنبي التي لم يستطع طه حسين أن يفهمها أو يحللها ، إن عجز طه حسين عن فهم طبيعة شخصية المتنبي يعود إلى الطريقة التي تعامل بها مع النص الشعري باعتباره وثيقة، إذ كان يسلك طريقة انتقائية، يحاول من خلالها رسم شخصية المتنبي، فهو لم يتعامل مع النصوص الشعرية باعتبارها مجالا للتخييل والإبداع وإنما كان يستغلها استغلالا وثائقيا، وراح يحشد مجموعة من العناصر لا علاقة لها بفهم النص وطريقة اشتغاله ولكي يحافظ على منطقه في التاريخ الأدبي انتقل للحديث عن تأثير البيئة في تكوين شخصية الشاعر، فتحدث عن البيئة الكبرى أي عن الحياة العراقية في القرن الثالث والرابع، راصدا ما آلت إليه الأمور من فساد سياسي واقتصادي، وما وصلت إليه من رقي عقلي.مطبقا مفهومه الخاص للقومية المنبني على الاعتداد بالجانب الاقتصادي، فقد ركز في حديثه عن هذه اللحظة التاريخية عن الحالة السياسية مبرزا ما اتسمت به من قلاقل وثورات، مثلت هذه الأخيرة ذات البعد الاجتماعي، لديه حركات تحررية تسعى بالأساس إلى تحسين الوضع الاقتصادي بالإضافة إلى أنها ثورات تهتم بتقوية الشخصية الفردية يقول " ولعل أخص ما تمتاز به هذه الثورات الثلاث (البابكية، ثورة الزنج، ثورة القرامطة) أنها كلها كانت تقصد إلى تغيير الحالة الاقتصادية بحيث تريد توزيع الثروة بين الناس، وبتحقيق شيء من العدل والمساواة بين الأفراد والجماعات، وكذلك إلى تقوية الشخصية الفردية، وتحريرها من القيود والأغلال التي فرضها عليها النظام الديني والسياسي والاجتماعي "، نلاحظ أن طه حسين يقرأ الماضي بهموم الحاضر، انطلاقا من اتجاهه الليبرالي الذي يعلي من شأن الفرد والحرية.
لقد ساق هذا الحديث المطول عن العصر وتقلباته ليصل إلى المتنبي، ويبين أثر العصر في تركيب شخصيته، وأن المتنبي ما هو إلا ثمرة لهذا العصر فقد " ولد المتنبي في بيئة كان الدم يصبغها من حين إلى حين ... وإنما كان يصبغها صبغ آخر ليس أقل نكرا من سفك الدماء هو النهب والسلب، واستباحة الأعراض وانتهاك الحرمات، والاستخفاف بقوانين الخلق والدين ".
إن طه حسين يطبق نظرية هيبوليت تين في التاريخ الأدبي، هذه النظرية التي تقوم على عنصر (البيئة- العصر-الجنس).
إن تأطير المتنبي ضمن البيئة الكرى التي عاش فيها والزمن التاريخي، بالإضافة إلى الحديث عن جنسه (العربي)، كلها مداخل تبرز لنا مدى استمرارية وامتداد منهج تاريخ الأدب وأدوات التحليل في مشروعه النقدي.
إن هذه المداخل التي اعتبرها طه حسين مسؤولة عن تشكيل شخصية المتنبي، ستبرز في طريقة تناوله للشعر الذي قاله المتنبي في صباه، بحيث توقف عنده طويلا ليستخلص منه أثر البيئة.
لقد حاول طه حسين أن يستخرج من هذا الشعر مجموعة من الخصال حددها في ثلاث :
1.الخصلة الأولى أن الصبي مقلد في الفن الشعري.
2.إن هذا الشعر، شعر صبي متشيع للعلويين، متأثر بآراء الشيعة وبآراء الغلاة منهم.
3.أن هذا الشعر شعر صبي لم يكن بعيدا كل البعد عن أمور القرامطة وأخبارهم2.
لقد أثار مسألة قرمطية المتنبي وتأثره بمذهبهم، إذ يؤكد أن الشاعر بعد عودته من البادية في الشام كان قد تشبع بالمذهب القرمطي وصار داعية له، فهو يرى أن " رحلة المتنبي إلى البادية نفعته من الناحيتين جميعا، فقد ربا جسمه، ونما عقله وفصح لسانه، وتعلم أصول القرامطة، وعرف مذاهبهم النظرية والعملية معا، وشعر المتنبي في صباه بعد عودته من البادية إلى الكوفة، بين لنا هذا أوضح تبيين .
إن هذه القضية التي استخصلها طه حسين من شعر المتنبي كانت مثار خلاف ونزاع بين الدارسين، ولمناقشة هذه القضية سنعرض لمجموعة من الآراء المختلفة حولها مقارنين بينها ومبرزين دوافع الاختلاف.
لقد ذهب طه حسين إلى أن المتنبي كان قرمطيا ثم خانهم في آخر أيامه فقتلوه، ولقد حاول أن يثبت هذا الأمر في أكثر من موضع من كتابه.
أما عبد الوهاب عزام، فإنه ينفي أن يكون المتنبي قرمطيا، ويقرر أن قرمطية المتنبي يعوزها الدليل، في حين أن محمد محمد حسنين يقرر عكس ما ذهب إليه طه حسين، من أن المتنبي كان في نظره عدوا للقرامطة وخصما للباطنية يناصبهم العداء، ويؤكد محمد حسنين أن القيم التي نادى بها المتنبي في شعره تناقض مبادئ الشعية في الولاية أي الإمامة، وتنكر عصمة الإمام والانقياد لأمره . أما محمود شاكر، فيرى أن المتنبي ليس قرمطيا، وإنما هو علوي النسب اضطره العلويون إلى ستر هذا النسب بعد أن فرقوا بينه وبين أمه .
أما المستشرق " ماسينون " ، فيرى أن المتنبي كان قرمطيا على مذهب الباطنية الإسماعلين، وذلك أن ماسينيون كان مولعا بإظهار النزعة الباطنية الإسماعيلية لدى عديد من الشخصيات العربية الإسلامية، ويرجع ذلك إلى نزعة المسيحية. في حين أن المستشرق الفرنسي " رجيس بلاشير " نفى أن يكون المتنبي قرمطيا، غير أنه أشار إلى أنه كان متأثرا بآرائهم.
إن هذا الاختلاف بين الدارسين مرده إلى اختلاف زوايا النظر، وإلى غموض المرجعيات المعتمدة في تحقيق هذه القضية، فالقدماء لم يشيروا إلى هذا المنزع المذهبي عند المتنبي، وإنما وجدناه فقط عند الدارسين المحدثين، الذين ولعوا بالحديث عن الأصول الفكرية والذهنية عند الكتاب والشعراء، ويبدو أن عبورهم من الشعر كتخييل إلى الشخصية الواقعية كان سببا في إثارة هذا النوع من القضايا، ولتأكيد هذه المسألة أو نفيها لابد من استنطاق المتن الشعري كله لدى المتنبي، فإذا سلمنا جدلا مع القائلين بقرمطية المتنبي فإنهم ملزمون بإخراج هذه المبادئ القرمطية من شعره كله، وهل كان المتنبي بالفعل يسلك في حياته اليومية مسلك القرامطة ؟
إذا استقصينا الديوان، فإننا نجد بعض اصطلاحات القرامطة المشتقة من مبادئ الإسماعيلية، وقد ظهرت هذه الاصطلاحات في فجر شبابه، إذ استعملها في بعض مدائحه يقول مثلا :
يا أيها الملك المصفى جوهرا
من ذات ذي الملكوت أسمى من سما
نـور تـظاهر فيك لاهـوتيه
فـتكـاد تعـلم علم مـا لـن يعلما
ويقول في القصيدة التي مدح بها أبا القاسم طاهر بن الحسين العلوي :
وأبـهـر آيات التـهـامـي أنه
أبـوك وإحــدى ما لكم من مناقب
إن هذا البيت أثار حفيظة الشراح في القديم، وهو بيت في ظاهره لا يساير الروح الإسلامية، حيث ذهب فيه المتنبي مذهبا غاليا، جعل الممدوح من أبهر آيات الرسول عليه السلام، وهذا الأمر فيه شناعة. لقد استنكره ابن جني الذي يعتبر مريدا للمتنبي ومتعصبا له، إذ يقول : " قد أكثر الناس القول في هذا البيت، وهو في الجملة شنيع الظاهر، وقد كان يتعسف في الاحتجاج له والاعتذار عنه بما لست أراه مقنعا " .
وبالإضافة إلى هذه الاصطلاحات القرمطية، فإنا نجد أيضا ملامح للمذهب العلوي، فهو يقول مادحا :
كذا الفاطميون الندى في بنانهم
أعزا محاء من خطوط الرواجب
أنـاس إذا لاقــوا عـدى فكأنما
سلام الذي لاقوا غبار السلاهب
إذا علوي لم يكن مـثـل طاهـر
فما هـو إلا حـجة للنواصب
هو ابن رسول الله وابن وصيـه
وشبهها شبهت بعد التجارب
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إننا نجد بعض اصطلاحات المتصوفة تتخلل بعض قصائده . فهل نذهب إلى أن المتنبي كان صوفيا.
لابد أن نؤكد أن المتنبي استطاع أن يتمثل ثقافة عصره، ويوظفها توظيفا شعريا، فهو قد نشأ ضمن زمنيته الراهنة إذا التقط ما يروج في عصره من عقائد ومذاهب فكرية، وسياسية، وفلسفية، وركبها في شعره بطريقة فسيفسائية ستجيب لرؤيته الشعرية المؤسسة على تمجيد الذات ونشدان القوة.
تبقى مسألة أخرى قد توهم بأن المتنبي كان قرمطيا، هي حبه لسفك الدماء، إذ من المعلوم أن النزعة القرمطية تحب سفك الدماء والتطلع للقتل واستباحة أعراض الناس وأموالهم.
فالمتتبع لشعر المتنبي خاصة في مراحله الأولى يجد أن هذا الشعر يطفح بالصور التي تعكس تعطشه للدماء والقتل، فقد أخبرنا ديوانه بأنه كان لا يزال يافعا في المكتب بالكوفة وكان غزير الشعر، فقيل له ما أحسن هذه الوفرة، فأجاب :
لا تحسن الوفرة حتى ترى
منشورة الضفرين يوم القتال
على فتى معـتــقـل صعدة
يعلها مـن كـل وافي السـبال
ويبرز إعجابه بالقرامطة في صباه فينشئ قصيدته المدحية التي ضمنها كل المعاني التي تحض على سفك الدماء، يقول في مطلعها :
ضيق ألم برأسي غير محتشم
السيف أحسن فعلا منه باللمم
وإذا كانت هذه الميمية تعكس أصداء الأعمال التي كان يقوم بها القرامطة خاصة عندما أغاروا على مكة سنة 317 هـ، وقتلوا آلاف الحجاج من الرجال والنساء حول البيت الحرام، فإننا نجد هذه النزعة لسفك الدماء تصاحب الشاعر طوال حياته، إذ نجده يوشح قصائده المدحية بصور ومشاهد من القتل يقول في إحدى قصائده التي مدح بها على بن عامر الأنطاكي :
ولا تحسبن المـجـد زقا وقـينة
فما المجد إلا السيف والفتكة البكر
وتضريب أعناق الملوك وأن ترى
لك الهبوات السود والعسكر المجر
وتركك في الـدنـيـا دويا كأنما
تداول سمع المرء أنمـله العشر
إن هذا التعطش للدماء في شعره يحتاج من الباحثين التوقف طويلا، خاصة وأن هذه النزعة أضحت ظاهرة هجاسية Obsessionnelle تتواتر في شعره كله، وأنجع السبل لدراسته هذه الموضوعة، هو أن نستخرج الحقول الدلالية التي ترد فيها، محاولين ربطها بالأفق الذي يرسمه الشاعر لعالمه المتخيل لكي نخلص إلى رؤية العالم لديه المتنبي. أما ربط هذه الصور الدموية بطريقة ميكانيكية بالنزعة القرمطية، فإنه لا يضيف شيئا بالنسبة لفهم دلالات الشعر عند المتنبي وإنماسيكون فقط تحصيل حاصل، فنحن سنجد المتنبي في إحدى قصائده يسخر بالقرامطة وبزعمائهم، حين هزمهم سيف الدولة سنة 337هـ ، يقول :
وجيش أمام على ناقة
صحيح الإمامة الباطل
ستخلص مما سبق ذكره أن المتنبي شاعر استطاع أن يدغم الأحداث التي كانت تعج في زمنه، وكان شعره شاهدا على الأحداث المهيمنة في عصره وليس مؤرخا لها. ولا نقول بأن " أبا الطيب كان قرمطي العقيدة في صباه الأول، قرمطي السبق والعزم في فترة طويلة في شبابه "
وإذ نقول بأن شعر المتنبي عكس لنا اللحظة الزمنية، فلا نعني بذلك انعكاسا مرآويا، إذ لم يكن يؤرخ لعصره، وإنما كان يلتقط أهم الأحداث ويصوغها صياغة شعرية، هذا الشعر هو نتاج لترسبات ومقروءات متنوعة، فنحن نجد أصداء شعر الفروسية لديه، خاصة شعر عنترة الذي كان يمجد السيف ويفتخر بالقتل والتفنن فيه، ولابد أن نشير إلى أن النزعة الدموية عند المتنبي تتفاعل مع نصوص الشعراء لسابقين خاصة شعراء الحماسة والفروسية .
| |
|
  | |
الشهبندر
عضو نشيط 
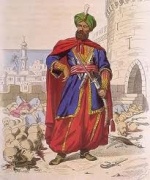
الجنس : 
العمر : 40
 المدينة المنورة المدينة المنورة
التسجيل : 30/09/2011
عدد المساهمات : 141
 |  موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩ موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩  الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:59 pm الأحد 13 نوفمبر 2011, 9:59 pm | |
|
- المتنبي بين التغيير والتطور :
إن مفهوم التغيير والتطور من المفاهيم الأساسية في التاريخ الأدبي لدى طه حسين، إذ يرتبط مفهوم التـغـيـر بتـصوره للــعوامل التي تنتج النص، وهذه العوامل ترجع إلى مفهومي " الجبر التاريخي " و " الجبر النفسي ". فالأول له علاقة بمرآة المجتمع في حين أن الثاني يرتبط بذات الأديب، وما يوجد بين المفهومين هو مبدأ المحاكاة، فالأديب يحاكي ذاته ومجتمعه، فيكون بذلك مرآة تنعكس فيها التحولات النفسية والمجتمعية.
إن العلاقة الناظمة لهذين العنصرين هي علاقة العلية، حيث يتغير المعلول نتيجة لتغير العلة، فإذا " كان الأديب يعكس وضعا اجتماعيا فيغدو مرآة للمجتمع، ويعكس وضعا فرديا فيغدو مرآة للأديب فمن المنطقي أن يتغير الأدب نتيجة كل تغير بحدث في الأصل الفردي أو الاجتماعي الذي يعكسه ". وهذه السمة التطورية للأدب تتسم بالحتمية، حيث أن قانون التطور يتجاوز إرادة الفرد والمجتمع.
غير أن مفهوم التطور يتحدد عند طه حسين في علاقته بمفهوم الثبات، فالأول يشير إلى التغير والتجدد، والثاني يشير إلى السكون والجمود، إن التاريخ الأدبي للامة العربية وباقي الأمم الأخرى يخضع لهذين القانونين، إذ أخص " ما نلاحظه في حياة أدبنا العربي منذ أقدم عصوره أنه يأتلف من عنصرين خطيرين لا يحتاج لاستكشافهما إلى جهد أو عناء، أحدهما داخلي يأتيه من نفسه ومن طبيعة الأمة التي أنتجته والآخر خارجي يأتيه من الشعوب التي اتصلت بالعرب أو اتصل العرب بها، ويأتيه من الظروف الكثيرة المختلفة التي أحاطت بحياة المسلمين فيها على مر العصور ". فالتاريخ الأدبي عنده يعتمد على العنصر الخارجي للتطور أكثر من اعتماده على العنصر الداخلي للثبات. لأن التاريخ عنده "يعتمد في تحديده على المؤثرات الكبرى التي تحدث تطورا في الأدب فتخرجه من وضع إلى وضع، وعلى التيارات التي تدخله فتحرره من بعض الصفات وتلحق به بعض الصفات الأخرى ". وما يترتب عن هذا التصور هو أن العلاقة بين تطور المجتمع وتطور الأدب علاقة آلية. إذ كلما " تغيرت ضروب العيش وجب أن يتغير الشعر ".
فما هي انعكاسات هذا المفهوم التطوري للظواهر الأدبية على تعامل طه حسين مع الأدب والتاريخ له ؟ إنه بموجب العلاقة العلمية، سينظر للأدب على أنه ظاهرة تطورية تخضع لمنطق تعاقبي تصاعدي، وستتحدد قيمة النص الفنية من خلال الحركة المتصاعدة عبر الزمن، وسنكون أمام ظاهرة تحاكي نمو الإنسان، من الطفولة إلى الشيخوخة، فالأدب في نظره، يبدأ كالطفل، وما يسم هذه المرحلة هو التقليد والمحاكاة، وبمجرد ما ينتقل الأديب إلى طور آخر من حياته ينضج أدبه ويتغير.
فكيف تجلى هذا المنظور التطوري من خلال كتاب " مع المتنبي " وما هي النتائج التي ترتبت عنه في قراءة الخطاب الشعري ؟
إن حركة التاريخ الأدبي في الكتاب حركة خطية أفقية تزاوج بين المجتمع والفرد، وتبحث في التأثيرات التي مارستها الحياة العامة والخاصة على شعر المتنبي، لذلك فقد رأينا طه حسين يقدم بين يدي دراسته فرشا عاما عن العصر الذي نبت فيه الشاعر، ليخلص إلى الأحداث الكبرى التي تحكمت في حياته، وكان لها تأثير بالغ في تكوين شخصيته. يقول : " إني لم أثر هذه المناقشة الطويلة لأعرف أكان المتنبي عربيا أم أعجميا، وإما أثرتها لأنتهي منها إلى حقيقة يظهر أنها لا تقبل الشك، وهي أن المتنبي لم يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته ولا أن بجهر بذكر أمه وأبيه، ألتمس بذلك ما شئت من علة، فهذا لا يعنيني، وإنما الذي يعنيني ويجب أن يعنيك، هو أن شعور المتنبي الصبي بهذه الضعة أو بهذا الضعف من ناحية أسرته وأهله، قد كان العنصر الأول الذي أثر في شخصية المتنبي وبغض إليه الناس رأى نفسه شاذا لأمر ليس فيه يد، وليس له عليه سلطان، ففكر تفكير الشاذ وعاش عيشة الشاذ ".
نلمح في هذا الاستشهاد أن طه حسين أعتمد مقولة الجبر النفسي، حيث ركز على أن المتنبي هو استجابة سلبية لظروف خارجة عن إرادته، فهو ليس مسؤولا عن وضعه الشاذ، لكنه يعتبر ثمرة لهذه العلة الخارجية، هذه العلة ستتحكم في توجيه شعره منذ الصبا إلى النضج، ولقد ترتب عن هذا الفهم تفسير الظاهرة الشعرية انطلاقا من عوالم خارجية، إذ استجابات الشاعر من خلال هذا المنظور هي نتاج لمشيرات خارجية، سيكون فيها المتنبي مرآة تعكس بطريقة سلبية عوالمه الداخلية.
بعد رؤيتنا لهذه المفاهيم المؤسسة للعملية التاريخية سنتتبع الخط الأفقي الذي رسم من خلاله طه حسين مسيرة التطور الشعري لدى المتنبي.
الحركة الأفقية من خلال كتاب مع المتنبي :
إن التطور الشعري يرتبط عند طه حسين بعنصري البيئة والزمان، إذ كلما تغيرا يتغير الفرد في علاقته بهما، ومن تم يكون هذا التغيير مسؤولا على نمو الشاعرية، لذلك سيلاحظ المتتبع لحركة التاريخ الأدبي في الكتاب أنها ستنطلق من نقطة البداية التي هي طفولة الشاعر. فكيف قرأ طه حسين شعره هذه المرحلة ؟
1- الكوفة والطفولة الغامضة :
إن طفولة المتنبي مجهولة ويكتنفها الغموض ، فهي طفولة " مجهولة بالطبع كطفولة غيره من
الشعراء الذين عاصروه أو سبقوه " ، وقد رد طه حسين غموض هذه المرحلة من حياة الشاعر لغموض أمر أسرته ، لكن هذا التعليل غير كاف بحيث أنه يغيب السبب الرئيسي لغموض هذه المرحلة ، فليست حياة المتنبي الصبي هي الوحيدة التي اكتنفها الغموض ، بل أغلب الشعراء والكتاب لا نظم لهم بتأريخ لهذه المرحلة من حياتهم ، وذلك راجع للسنن الثقافي الذي تحكم في التاريخ للأدباء ، فالثقافة الكلاسيكية لم تهتم بهذه المرحلة من حياة المبدعين ، إذ نجد البداية الفعلية لحياة المبدع تبدأ منذ التقائه بشيوخه ، بمعنى عندما ينتقل المرء من الطبيعة إلى الثقافة ".
ولقد عمد طه حسين إلى الشعر الذي قاله المتنبي في صباه محاولا تسليط الضوء على هذه المرحلة في حياته. ومستخلصا طبيعة هذا الشعر.
لقد سبق أن أشرنا إلى أن الخط الذي رسمه طه حسين لتطور الفن الشعري يبدأ من طفولة الشاعر ، وهذه اللحظة تعتبر في نظره هي طفولة الشعر ، وما يميز هذه المرحلة الطفولية هو التقليد والتصنع ، فهو يقول بأن " الأصل في الابتداء الفني التقليد بحيث يقلد المبتدأ واحدا أو غير واحد من الذين سبقوه في الفن الذي يزاوله ".
نلاحظ من خلال هذا التصور للعملية الإبداعية أن الشاعر يدخل العالم الشعري وهو يحبو كالطفل.
لقد عمد طه حسين لشعر هذه المرحلة ، بعدما سطر مجموعة من الخصال بصمت هذا الشعر ، وما يلاحظ هو أنه لم يؤرخ للمقطوعات التي قيلت في هذه المرحلة ، وذلك راجع إلى أن هذا الشعر لم يؤرخه لا القدماء ولا المحدثون. وإنما ورد في نسخ الديوان بدون تاريخ.
بعد أن قدم الخصال الأربعة 1 لهذه المرحلة ، راح يعتمد على المتن الشعري ليؤكد هذه الخصال، مخللا قراءته ببعض الوقفات على الجانب الصناعي لهذا الشعر. ولقد تحكم في قراءته المبدأ العام الذي انطلق منه في تصوره للطفولة باعتبارها لحظة تقليد ومحاكاة لذلك حكم مسبقا على هذا الشعر بالتكلف والتصنع والاحتذاء.
بالإضافة إلى أنه لم يعتمد هذا المتن ليدرسه في ذاته وإنما جعله وسيلة " ليرى هل هذه المقطوعات تصور حقا كل هذه التي أحصاها ".
وسنعرض لبعض النماذج التي توقف عندها مبرزين آليات القراءة التي اتبعها. وأول نموذج توقف عنده هو هذان البيتان :
بأبي من وردته فافترقنا
وقضى الله بعد ذلك اجتماعا (الخفيف)
فافترقنا حولا فلما التـقينا
كان تـسليمه علي وداعــا
لقد سلك مجموعة من الخطوات في قراءته لهذين البيتين ، فكان أول ما ابتدأ به أنه عمد إلى نثرهما سالكا طريقة " حل المعقود " ، ثم انتقل إلى الكشف عن الدافع الذي كان وراء هذين البيتين مركزا على " أن الفكرة التي حملت الصبي على أن ينظم هذين البيتين هي هذه التي توجد في الشطر الأخير من البيت الثاني وهو : كان تسليمه علي وداعا " 1. نسجل هذا الصدد أن ما يتحكم في قراءته هذا إيمانه بالفصل بين ثنائية اللفظ والمعنى ، فالشاعر في نظره يعمد إلى فكرة مسبقة ثم يبحث لها عن البناء الشعري. بعد ذلك انتقل إلى الوقوف عند بعض جزئيات البيتين ، معلقا على ذلك بقوله " فكلمة وددته هنا نابية قلقة مكرهة على الاستقرار في مكانها الذي هي فيه ، أراد الصبي أن يقوله أحببته فلم يستقم له الوزن " .
إن هذا التعليق نموذج لتعامل طه حسين مع الشعر. وهو نموذج ينتمي لحقل كلاسيكي أصوله في النقد العربي القديم ، إذ يعمد إلى قراءة الجزء دون الكل ، وإن هذا النوع من القراءة تنعكس سلبياته على تقييم الشعر والحكم عليه.
لقد جانب الصواب في الحكم عـلـى هـذه الكلمة، إذ لـو أراد المـتنبي استعمال كلمة "حببته " مكان " وددته " لاستقام له الوزن، فمكونات وددته تساوي من الناحية الوزنية أحببته، لكن الشيء الذي غاب عن طه حسين هو التساؤل عن الدافع الذي جعل المتنبي يختار مادة ودد عوض مادة حبب. لقد حاول معاصره العقاد أن يجيب عن هذا التساؤل بعد أن قام بعملية استقرائية لمادة " ود " في ديوان المتنبي ورأى بأن " المودة هي الكلمة العربية التي تقابل كلمة " Tendresse " في الفرنسية، وتطابق معناها تمام المطابقة، وهو ذلك الحب الرقيق الذي فيه حنو وشوق ، وليس فيه عنف ولا اعتلاج، وليست في اللغة العربية كلمة هي اصح لهذا المعنى من " وددته التي اختارها الشاعر ، وليجرب الدكتور أن يغيرها في كلام منثور فسيعلم أن هذه الكلمة في نظم المتنبي الصبي هي أشبه الكلام بنظم المتنبي الكبير" .
لم يلمح طه حسين البعد النفسي لهذه الكلمة ، ومرد ذلك أنه يقرأ الديوان قراءة خطية لا عمودية، بالإضافة إلى انطلاقه من أن شعر الطفولة هو تقليد وصنعة وتكلف. وطبيعة هذه القراءة لا تنفذ إلى عمق الخطاب الشعري باحثة عن الخيوط الناظمة لبنيته ونسيجه. ونحن لا شك في قدرة طه حسين على تذوق الشعر ، غير أن أدواته المنهجية تحول بينه وبين إدراك خبايا النص ، لأن النص في نظره لا يدرس لذاته، وإنما يدرس لاستخلاص الشواهد على صحة الفروض التي ينطلق منها.
بعد مرحلة التعليق على النص ، ينتقل إلى الحكم عليه، ولقد اتسم حكمه بالانطباعية والتأثرية، بحيث يسجل الوقع الذي يتركه في نفس متلقيه يقول " وسواء أكان هذا الشعر جيدا أم رديئا مستقيما أو ملتويا، فإني أجد في نفسي حبا له وميلا ، لأني أتمثل هذا الجهد العنيف الذي بذله الصبي الذكي، حتى استخرج هذين البيتين " .
يصدر طه حسين في أحكامه عن العاطفة لا عن الفن ومثل هذه الاستجابة الانطباعية تحول دون تقييم الجانب الجمالي في النص ، ويذكر نهج طه حسين بتلك الأحكام الانطباعية التي كان يصدرها النقاد العرب القدامى في الطور الشفوي للنقد.
وبعد توقفه عند هذين البيتين انتقل للحديث عن مقطوعة من ثلاثة أبيات وقرأها بنفس الطريقة السابقة. ويورد بعد ذلك بيتين قالهما المتنبي الصبي في المكتب وهما :
لا تحسن الوفرة حتى ترى
منشورة الظفرين يوم القتال
على فتى معتقل صعدة
يعلها من كل وافي السبال
يعلق عن هذين البيتين بقوله إنهما يشتملان على " جزالة مطبوعة لم نلحظها في الأبيات السابقة وإنهما بريئان من الصنعة والتعمل ، وإنهما يصوران نــــزاع الـــصبي إلى الحرب والـقتال ".
أول ملاحظة نسجل بصدد هذا الحكم أنه حكم عام يلقى على النص دون التوقف عند مكوناته ، ويعكس الغاية التي من أجلها يدرس النصوص ، بحيث نراه يبحث في الأبيات عن مدى تصويرها لنفسية الشاعر وبيئته.
وما يغيب في هذا الحكم هو رصد عوامل التطور داخل شعر هذه المرحلة ، إذ لم يوضح كيف انتقل المتنبي داخل هذه المرحلة من التعمل والتكلف إلى البراءة منها.
وما ذكرناه بصدد هذه المقطوعات ينسحب على باقي المقطوعات ، والمبدأ الثابت في قراءة طه حسين هو تركيزه على إبراز مرآوية هذا الشعر ومدى تصويره لبيئة الشاعر ونفسيته. بالإضافة إلى أنه يصدر أحكاما متنافرة حول شعر هذه المرحلة فمرة نجد المتنبي متكلفا متصنعا ومرة نجد شعره مطبوعا ومرة نجده يتصرف في الكلام كما يجب. إن هذه الأحكام غير منسجمة ، وقد يرجع ذلك إلى الجهاز المفاهيمي الذي يصدر عند الناقد، بحيث تتجاوز فيه الطريقة الكلاسيكية في النقد ( القراءة الأفقية للقصيدة بيتا بيتان ثم الوقوف على العناصر الجزئية المكونة للنص )، مع النزعة الانطباعية ( التي تصدر عن العاطفة دون تعليل أو تفسير للوقع إجمالي ). بالإضافة إلى التمسك بمبدأ مرآوية الأدب.
لقد حاول طه حسين أن يستخلص مجموعة من الخلاصات بصدد شعر هذه المرحلة ن حيث ابرز أن المتنبي في هذا الطور اتجه بعض الاتجاه إلى مذهب أبي تمام ، وأنه نشأ نشأة شيعية غالية لم تلبث أن استحالت إلى قرمطية خالصة ، وأنه لم يقطع المرحلة الأولى حتى " كان قد تم له حظه من الشعر " .
| |
|
  | |
امرؤ القيس
عضو مبدع 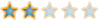

الجنس : 
العمر : 39
 الفلاة الواسعة الفلاة الواسعة
التسجيل : 05/09/2011
عدد المساهمات : 288
 |  موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩ موضوع: رد: ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩  الإثنين 02 أبريل 2012, 7:25 pm الإثنين 02 أبريل 2012, 7:25 pm | |
| | |
|
  | |
| | ۩۩ المتنبي .. دراسة تحليلية ۩۩ |  |
|



